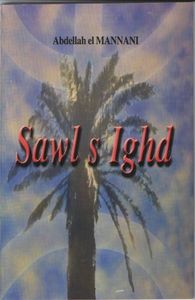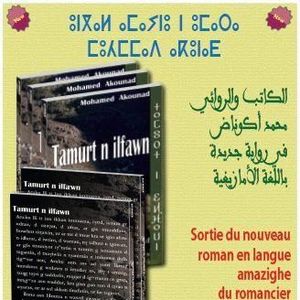0 comment
0 comment الأربعاء، 17 أبريل 2013
الأربعاء، 17 أبريل 2013
Tamdyazt tatrart s ughanib n mass Abdellah Elmnnani
"Sawl s ighd"
Mass
Abdllah lmnnani iga yan gh i3rrimn n ugadir ittwayssann s tirra ns gh
usays n tmdyazt tamaynut tatrart, issufgh-d gh usggwas n 2003 tawckint
ns tamzwarut n tmdyazin s ism n « sawl s ighd ».
Tadla n tmdyazin ttyara s uskkil alatin, gis 82 n tasna d sdîs d mrawt n tmdyazt Zilnin, iskras mass mohamed akunad tzwart ns.
yan ugzzum gh yat tmdyazt n twckint ad
tirgit izwarn:
ukigh-d s yat tiqqrt
lsgh yat twlaft
bikksgh s yat tilawt
ccgh kra n tgûdi
sugh kra n tguni
tirgit tis snat:
smnûdigh tudrt gh udlis
ssakwigh nn iwiz s isk
gagh ajda3 ar ffrdgh
gh ifrawn
n uzal
imndi ar iggan
ar-d zrigh
zluzzugh imal gh walim
a ig tirmt n ifullusn
ilint tglay
txlf tizi
 0 comment
0 comment
azul flawn aitma distma imazighen .n masri ( asdrfn uswingm d unili )
ad right ad ig asays n tirra s tmazight, negh tirra f warratn n tmazight
d tskla s udm ns amaynu, win tirra, ira ad isawal f mad ittffughen n
idêrisen n tskla d warratn ittyaran f tmazight. wan iran tamazight ad
sis yara, igher sis, ur-d ad ka fllas isawal, ar isaqqur macc izdegh
ilsawn yadên, yagwi ad-d sar gisn iffagh !
 0 comment
0 comment
irrut ul n umdyaz ifl d iwrman nns: iwrman n
Larbi MOUMOUCH
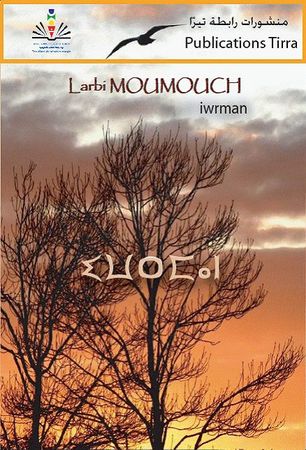
had tazlgha n tirra tDfr sul tizrigin nns s tlalit n twckint tamaynut n mass: larbi MOUMOUCH
Arra
ad lli d dagh tDi tzlgha n tirra ikcm g yat tstratijit ibddn f usbughlu
n igr n tskla, d usufgh n twwuriwin n imaratn n tmazight s mknna d unck
nna mi tzDar.
Arra
ad iga iswingimn d iDriSn nna turu twngimt n umara, luln d sg isyafatn d
tufrayin n tasa nns d inny n tiTT nns, yara tn s tutlayt yaDfutn d
iswan g tmdyazt, ilin ilmma gr tirra n tsrit d udm n tmdyazt, rad nn gis
yaf imghri isastnn n umara d tmughliwin nns s ullisn d wawal n izlan.
L3rbi
Mumuc bab n warra ad ittwayssan uggar g usays n usughl d ufran asklan,
issufgh d yad mnnawt twwuriwin g tskla tamaDlant, gant mkad:
- amnukal mZZiyn n Saint - Exupéry g 2007.
- tiguDiwin n bariz (Baudelaire) g 2008.
- ankaD (Franz Kafka) g 2010.
G usays n usnflul, issufgh as d usinag agldan (IRkAM) yat twckint n tmdyazin mi issagh: tirZi.
 0 comment
0 comment
ungal amynu n AKUNAD g mad nn ur yaggugn: tamurt n ilfawn
rad d iffgh ussan ad d yaZn ungal amaynu n mass Mohamed AKUNAD mi iga s ism: tamurt n ilfawn.
ungal n mass akunad ixatr, gis 200 p, ittyara s uskkil alatin, ar isawal s yat tgharast tasklant idran f imukrisn n imazighn d tmazirt n lmghrib akkw.
ungal ad ittyara s tmazight izdgn immimn, ig wis kraD ungaln lli d issufgh mass akunad, acku izwar yad is d issufgh sin ungaln ad:
- tawargit d imik gh 2004
- ijjign n tidi gh 2006.
ungal n mass akunad ixatr, gis 200 p, ittyara s uskkil alatin, ar isawal s yat tgharast tasklant idran f imukrisn n imazighn d tmazirt n lmghrib akkw.
ungal ad ittyara s tmazight izdgn immimn, ig wis kraD ungaln lli d issufgh mass akunad, acku izwar yad is d issufgh sin ungaln ad:
- tawargit d imik gh 2004
- ijjign n tidi gh 2006.

 0 comment
0 comment
tikttay
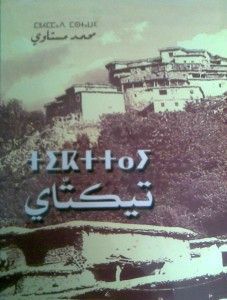
iffgh d tagara ad yan ungal amaynu yura t mass Mohamed Moustaoui, lli
ittwayssann s tmdyazt, issufgh d yad mnnawt twckinin g usays ad
(iskraf, taDSa d imTTawn, asays, taDDangiwin, ma za tnnit) d yan uDris
ismunn gr tmzgunt d ungal mi issagh hjju gh lbarlaman.
ungal ad n mass Moustaoui iga as s ism: tikttay, ittyara mklli s
ittwayssan moustaoui s uskkil n t3rabt, ig ungal wistam g tsga n sus
Darat n ungaln ad: imula n tmktit n afulay d tawargit d imik d ijjign n
tidi n akunad d ijawan n tayri n brahim lasri d uzrf akucam n abdellah
sabri igdad n wihran n lahoucine bouya3qubi d tawnza n fatima bahloul.
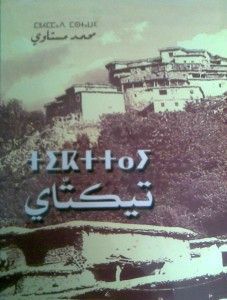
 0 comment
0 comment
تيمة الهجرة في الرواية الأمازيغية: ئكضاض ن وهران
رشيد نجيب
تعززت الساحة الأدبية الأمازيغية
بصدور عمل روائي بعنوان:”ئكضاض ن وهران” للمبدع الحسين بويعقوبي أنير، عمل
من شأنه أن يضيف أشياء جديدة للأدب الأمازيغي المكتوب بالمحاور أو التيمات
التي تناولها، ولكن كذلك بمختلف تقنيات وأساليب الكتابة التي وظفها الكاتب
من أجل صياغة عمله الأدبي الأول. فيما يلي قراءة أولية عامة لهذه الرواية
في رحلة عبر فصولها الستة وشخوصها والتيمات الواردة بها.
المؤلف:
يتضمن الغلاف الأخير للرواية نبذة
مقتضبة عن المؤلف بالفرنسية تبين أن الحسين بويعقوبي ازداد سنة 1974
بتاراست بأكادير، بعد حصوله على الإجازة في التاريخ والجغرافية بجامعة ابن
زهر، هاجر إلى فرنسا سنة 2002 لتحضير دبلوم الدراسات المعمقة بجامعة باريس
الثامنة. يحضر لنيل شهادة الدكتوراه في الأنتروبولوجيا بباريس. درس اللغة
الأمازيغية بمعهد الإنالكو، نشر سنة 2009 أول إصدار له حول محمد شفيق
ومساره النضالي من أجل الاعتراف باللغة والثقافة الأمازيغيتين بالمغرب.
ونسق أعمال مؤلف جماعي حول ” أمازيغ فرنسا” من إصدار جمعية تاماينوت فرنسا.
الرواية: تيماتها، أحداثها، شخوصها
تتناول الرواية موضوع الهجرة
كتيمة مركزية أساسية تتفرع عنها تيمات فرعية ترتبط بشخصياتها مثل: الهوية،
الحب، البطالة، العلاقة مع الآخر، حقوق الإنسان، الإسلام…إلا أن ما يجمع
بين كل شخصيات الرواية هي الهجرة والاغتراب وأحيانا النفي الاضطراري.
ظل سؤال الغاية من هجرة البطل
الرئيسي “ئدر” – الطالب المهاجر لاستكمال دراسته العليا – السؤال الأبدي
والأزلي الذي يطرحه على نفسه وفي ذات الوقت يتهرب من مجرد التفكير فيه حيث
يفتعل أي شيء للهروب من هذا السؤال. وستزداد حدة هذا السؤال بكثير من
الحرقة في لحظة السفر وتوديع الأب لابنه، لحظة حضر فيها البكاء وألم الفراق
تصورها الأب نوعا آخر من فقدان ابنه “ئدر” كما فقد أبناءه الثمانية جراء
إصابتهم بمرض وبائي بدوار “سيدي بوتماخيرت” قبل أن تقرر العائلة الرحيل عن
الدوار بناء على نصيحة من حكيمة القرية “ئبا ئجو” للحفاظ على ما تبقى من
الأبناء ( هجرة داخلية هذه المرة للحفاظ على حياة الأبناء وسلالة الأب).
يستغرق زمن رحلة “ئدر” مدة يومين
عبر الحافلة التي ستقطع المسار الرابط بين إنزكان وباريس. خلالها سيقدم لنا
الكاتب بورتريهات في قالب روائي لعدد من ركاب الحافلة المهاجرين للديار
الفرنسية: منهم “سعيد” الشاب المهاجر بدوره والممارس لكرة القدم ضمن إحدى
الفرق المحلية، له سابق معرفة ب “ئدر” بحكم نشاط هذا الأخير ضمن صفوف
الحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة. في العلاقة التواصلية بينهما، سيحضر
بقوة سؤال الهوية بشكل يبرز تناقضا جليا في منظور كل واحد منهما لقضية
الهوية بالمغرب. الشيخ السلفي الأمازيغي اللسان الذي بدأ الرحلة بإلقاء
موعظة دينية عن الآخرة وأهوال القبر مما سيثير حفيظة بعض الركاب خاصة من
الشباب حين لم تتطرق الموعظة إلى الجنة ونعيمها. ثم ” دا بوجميع” العجوز
المتزوج من امرأتين واحدة مستقرة بالمغرب وأخرى بالمهجر، يرفض السفر عبر
الطائرة مفضلا الحافلة، كثير الصراخ والتجشؤ، يعد سلفا الوجبات الغذائية
التي سيتناولها طيلة الرحلة. “براهيم نايت ئجا” الرجل الذي تفوح من حذاءه
رائحة نتنة مقززة، المرأة المثقلة بالمتاع برفقة رضيعها، الشابان الكتومان
المدمنان للمخدرات، الشاب والشابة في الحهة الخلفية للحافلة، المسافر
الراكب من الدار البيضاء والرافض لبث مواد بالأمازيغية في التلفاز المثبت
بالحافلة…وكأن الروائي هنا يريد أن يبين أن الأمر يتعلق بهجرات جماعية
متقطعة، الكل يريد أن يهاجر، لا فرق في ذلك بين الذكور والإناث، بين الشباب
والشيوخ وبين المتعلمين ودونهم…الجميع يريد الهروب من سجن كبير، لمن سيترك
كل هؤلاء بلادهم ؟ يتساءل الروائي.
حين يتحدث الروائي عن القرية التي
ينحدر منها وهي قرية “سيدي بوتماخيرت” حيث الحياة مرتكزة على أسس ثلاثة
هي: البحر- الأرض- بئر القرية، يستحضر عددا من عادات الأهالي في الاحتفاء
بالبحر خاصة ما يهم تقديم قربان سنوي له، وهو الذي يعتبر موردا رئيسيا لكسب
قوت يومهم، ويورد مغامرات بعض السكان في علاقتهم بالبحر مثل “لقبطان”
و”علي نايت بوحشوش”، كما يتحسر جراء تغيير الأهالي لوسائل الصيد التقليدية
المتوارثة عن الأجداد بأخرى حديثة. تركز السرد كذلك في هذا الفصل على
محاولات والد “ئدر” في الهجرة إلى فرنسا أثناء قدوم النخاس الفرنسي “فيليكس
موغا” للجنوب المغربي ورفض الجد لهجرة ابنه، ثم في مرحلة ثانية حين حصول
الأب على عقد عمل للعمل بفرنسا مع رفض الزوجة لذلك بدافع الغيرة. دون أن
يغفل الروائي استحضار التناقض المرتبط بالهجرة إلى بلاد المستعمر والتضحيات
التي قدمها الأجداد للكفاح ضده.
سرد الروائي عددا من الأحداث
المرتبطة باجتياز حاجز الجمارك في الفصل المعنون ب: “تاناوت ن ؤجنجم”،
ولعنوان الفصل دلالته في الإحالة على الإنقاذ والنجاة. أحداث ترتبط بكل
أنواع التهريب التي تتجاوز تهريب الذهب والمخدرات إلى تهريب البشر حيث يورد
قصة الشاب المعطل المهاجر بطريقة غير شرعية على متن نفس الحافلة بتواطؤ مع
سائقها. وعلى متن الباخرة المقلة للمسافرين إلى “الخزيرات” سيلتقي “ئدر”
بمهاجر من طينة أخرى هو الأستاذ الجامعي المتخصص في التاريخ والمغترب
لسنوات بسبب نضاله السياسي والحقوقي وسيتناول الحوار بينهما عددا من
القضايا من ضمنها قضية الهجرة السرية.
تيمة الحب في الرواية تحضر في
علاقة بطل الرواية بالمواطنة الفرنسية “ميلاني” التي سيغير اسمها إلى اسم
أمازيغي “تيميلا”، لقاء عابر في مقهى فرنسي سيؤسس لهذه العلاقة مع الآخر
بما يميزها من تمثلات وخلفيات واختلافات دينية واجتماعية وثقافية ونمط
للعيش كذلك، وسيتفق في النهاية كل من “ئدر” و”تيميلا” على بناء علاقتهما
على الأساس الإنساني المحض بعيدا عن كل المنغصات التي من شأنها قطع هذه
العلاقة.
حكاية أخرى من حكايات الهجرة
والاغتراب هي حكاية “دا محند نايت لكبوس” الشيخ السبعيني المهاجر منذ 1952
إلى وهران الجزائرية ضمن كوكبة من المهاجرين سموا اجتماعيا ” ئكضاض ن
وهران” . هذا الشيخ الذي كان يقوم بجمع تبرعات المواطنين المغاربة بفرنسا
لإرسالها إلى خلايا المقاومة بالمغرب للنضال ضد المستعمر.
تظل الهجرة التيمة المركزية التي
تتناولها رواية “ئكضاض ن وهران”، بنى الروائي أحداثها بسرد علاقة شخوصها
بالتيمة المتناولة، لكل شخصية حكاية خاصة يوردها المبدع إما بسرد وصفي
لمسارها بالنسبة للبعض أو بواسطة الحوار المباشر مع البعض الآخر، وكأن
المبدع أعد جذاذة أو بطاقة تقنية لكل شخصية على حدة.
أما السرد في هذه الرواية فلا
يتخذ منحنا تراتبيا تصاعديا حلزونيا مثلما هو معمول به في معظم الأعمال
الروائية، بل إنه يكاد أشبه بلعبة “البوزل” السحرية التي تتطلب من صاحبها
جمع وترتيب أجزاء صغيرة بدقة للحصول على الصورة الكاملة والنهائية بشكل
واضح. اللجوء إلى التراث كان جليا في الكثير من مقاطع الرواية خاصة بتوظيف
العديد من الحكم والأمثال الأمازيغية والإحالة على أسطورة حمو أونامير
لتوصيف العلاقة بين “ئدر” و “ميلاني”. على مستوى الكتابة، وظف الكاتب لغة
أمازيغية تعمد المستوى اللغوي لتاشلحيت مع الانفتاح التدريجي على اللغة
الأمازيغية المعيار واستعمال جمل وتعابير بسيطة سهل فهم الرواية. كما وظف
المبدع العديد من الأحداث التاريخية في تاريخ العلاقة بين المغرب وفرنسا
لبناء عمله الروائي.
رشيد نجيب، باحث في الثقافة الأمازيغية
 0 comment
0 comment
Ismdal n tmagit : au carrefour des identités perdues
1- Brahim Lasri Amazigh : le romancier d’Agadir.
L’apparition du roman, comme genre
littéraire nouveau dans la culture amazighe, s’impose comme l’un des
aspects majeurs d’une conscience identitaire qui s’inscrit pleinement
dans la modernité, qu’il soit au niveau de la langue employée, des
sujets traités ou encore des valeurs véhiculées4. Ismdal n
tmagit ne sort pas de la règle et s’inscrit dans cette perspective. Son
auteur déclare ouvertement être le romancier en amazighe des problèmes
citadins ou le romancier des Amazighs citadins. Il contribue ainsi à
changer une représentation très ancienne qui lie tout ce qui est
amazighe aux montagnes et au mode de vie rural. Brahim Lasri s’impose
également comme le romancier de la ville d’Agadir. Comme ce fut le cas
dans son premier roman, cette ville, où il est né et a vécu, l’inspire
encore une fois de plus pour être le lieu principal des événements de
son nouveau roman car elle résume toutes les mutations qu’une société
amazighe contemporaine puisse subir. Le tremblement de terre qui l’a
complètement rasé en 1960 donne à son histoire une dimension à la fois
tragique et humaine surtout que sa reconstruction ne lui a pas laissé la
possibilité de retrouver son « âme » perdue.
Par l’histoire de Samuel, l’un des
rescapés de cette tragédie humaine, l’auteur d’ismdal n tmagit, comme ce
fut le cas avec Mohamed Khïer-Eddine dans son Agadir, contribue à la
restauration d’une mémoire qui risque de se perdre. 62 ans après, le
roman en amazighe vient nous rappeler une tragédie humaine dont les
générations d’aujourd’hui ne connaissent même pas la date. À partir de
l’histoire de Samuel, l’auteur nous mène dans un long voyage dans le
temps et dans l’espace en quête d’une identité perdue. Samuel découvre
la complexité de la tache. Il ne s’agit plus d’une seule identité à
chercher mais de plusieurs sur la base de critères multiples : la
couleur, le prénom, le corps, la langue ou la religion. La langue du
roman est simple et compréhensible. Elle prend comme base l’amazighe du
sud du Maroc, normalisée, avec beaucoup de tolérance envers des emprunts
amazighisés (ex. tajyulujit (géologie), ttilibizyun (télévision),
tibyarin (bières), alaburatwar (laboratoire), adusi (dossier) etc). En
utilisant peu de néologisme (ex. tamagit (identité), iskkilen
(alphabet), asnfar (projet)…et dans un langage audacieux, comme ce fut
le cas aussi dans son premier roman, l’auteur traite de la complexité
d’un retour au pays de naissance dont on n’a pas acquis les codes.
2- La chute d’Agadir, la chute de l’agadir.
En amazighe du sud du Maroc, l’agadir signifie le grenier collectif5.
Très présent comme institution sociale, économique et même politique,
il sert à défendre le village, garder la nourriture et préserver les
documents (manuscrits et lois). Par ses fonctions, il représente
l’honneur du village et garde sa mémoire. Avec un « A » majuscule,
Agadir est le nom de l’une des grandes villes amazighes au sud du Maroc.
Petit village de pêcheurs avant 1912, il devient une ville moderne sous
le protectorat français (1912-1956). Grâce à sa très belle plage sur
l’Atlantique et à son climat ensoleillé toute l’année, elle est devenue
une grande destination touristique. Quatre ans après l’indépendance du
Maroc, cette belle ville vivante subit les conséquences d’un tremblement
de terre qui a eu lieu le 29 février 1960 (à 23h40), en plein mois de
ramadan, laissant derrière lui entre 12 et 15000 morts (soit un tiers de
la population). Agadir tombe et l’agadir chute6. Toute une
mémoire, toute une histoire et toute une identité tombe dans l’oublie.
La reconstruction d’Agadir n’a pas pris en compte la restauration de
l’agadir. Elle donne naissance à une autre ville, presque inconnue aux
yeux des survivants du tremblement. Une grande ville, immense, très
active économiquement. On y voit les biens faits et les inconvénients de
tout développement économique : grands hôtels, grand port de pêche,
boites de nuits, offres de travail, prostitution, tourisme, immigration.
En deux mots : richesse et pauvreté. Mais malgré cette croissance
économique, les générations des années 1950/60 déplorent leur ville
d’avant la tragédie.
3- Agadir entre l’Occident et l’Orient.
La reconstruction d’Agadir donna
naissance à une grande ville. Par ses activités économiques, où le
tourisme est central, la nouvelle ville se trouve ouverte sur le monde.
Si elle résiste difficilement pour garder quelques traits de son
identité amazighe, elle se trouve, à partir des années 1980, tiraillée
entre des influences idéologiques venues de l’Europe et celles venues de
l’Orient. Les personnages utilisés dans le roman sont appelés à jouer
des rôles permettant à l’auteur, sans qu’il puisse échapper aux
représentations qu’il a sur les deux régions (l’Occident et l’Orient),
de montrer ce croisement de choix idéologiques que se disputent la ville
d’Agadir. Dès le début, un jugement positif est porté sur l’Occident.
Mr Thibault, géologue français, enseignant à la Sorbonne et connaisseur
de la ville avant qu’elle ne tombe, incarne ce jugement (p.49). Il
parlait même l’amazighe. Il décide, juste après le tremblement de terre,
de porter son aide à la reconstruction de la ville et, pour cela, met
en place un laboratoire de réflexion. Il se présente ainsi comme homme
de grand cœur, porteur du savoir et respectueux de la culture locale.
Contrairement à ce regard positif sur l’Europe, l’Orient n’envoie à
Agadir que le tourisme sexuel, l’intégrisme religieux et le mépris de la
dignité des gens d’Agadir. Le touriste saoudien reflète parfaitement
cette image. Pendant ses séjours sexuels à Agadir, il se marie avec
Fadwa, originaire de Casablanca et l’une des prostituées de la ville.
Elle s’installe en Arabie Saoudite, met la burqua et adopte
le wahabisme. Devenue intégriste, elle fait de la propagande de son
idéologie au Maroc, en envoyant des livres religieux, des cassettes de
prêches et des burquas à sa copine Fadna, la cousine de Samuel. Entre
ces deux tendances, Ziri (p. 37), représente les jeunes d’Agadir qui
militent pour sauvegarder et promouvoir l’identité amazighe de leur
ville. Très cultivé et parlant plusieurs langues, il est très proche de
la bande de copains de Mr Thibault et méprise les Saoudiens.
C’est dans ce contexte que Samuel, le
personnage principal du roman, revient à Agadir. Il était l’un des
bébés-rescapés du tremblement, alors qu’il n’avait que 2 ans. Encore une
fois, c’est de l’Europe que vient un geste humain. Une famille suisse
l’a adopté et élevé dans un petit village suisse. Samuel ne connaissait
rien de son histoire. Il se considérait tout simplement comme Suisse et
chrétien jusqu’à ce qu’il devienne conscient de sa différence. Sa
couleur, très différente de celle de ses parents blancs et de ses
voisins suisses, le pousse à poser des questions sur son identité.
Est-il vraiment le fils de ses parents ?
4- La couleur: un signe identitaire visible.
Une fois adulte et conscient, Samuel
remarque que sa couleur bronzée est très différente de celle de ses
parents. Un marqueur identitaire qu’il ne peut pas cacher. D’où vient-il
alors ? Plusieurs peuples du monde portent sa couleur. Il peut être
Brésilien, Colombien, Libanais, Syrien ou Turc. Dans tout les cas, il ne
peut pas être Suisse. Annette et son mari sont-ils ses parents
génétiques ? Samuel ne savait pas que cette question, qui deviendra un
vrai casse-tête pour lui et pour ses “parents”, l’emmènerait dans un
voyage vers l’inconnu. Si tous les êtres humains avaient la même
couleur, le problème ne se poserait même pas, conclut Samuel. (p.14).
Après son insistance, il réussit à savoir la vérité. Ses parents
génétiques sont d’Agadir. Ils sont morts, peu d’années après leur
mariage, dans le tremblement de terre. Samuel, après avoir fini ses
études universitaires en Géologie, décide alors d’aller à Agadir,
pendant les années 1980 pour découvrir sa ville d’origine et chercher le
reste de sa famille.
5- Le prénom : un marqueur identitaire fluctuant.
Un prénom n’est pas seulement un mot qui
te distingue des autres membres de ta communauté (petite ou grande), ou
du reste du monde, il constitue surtout un support identitaire, très
chargé culturellement et idéologiquement. Le choix d’un prénom est aussi
très lié aux contextes historiques et aux influences qu’il peut avoir. A
titre d’exemple, pendant les années 1960/70, porter le prénom de Jamal
était étroitement lié à l’impacte qu’exerçait Gamal Abdel Nasser
(1918-1970), ancien président égyptien et leader panarabiste, sur les
sociétés dites « arabo-musulmanes ». Dans le même contexte, les prénoms
comme Abdel Halim, Farid, ou Keltoum étaient le reflet de l’influence
des fameux chanteurs égyptiens Abdel Halim Hafez (1929-1977), Farid Al
Atrach (1910-1974) ou Oum Keltoum (1898?-1975). On peut constater aussi
la même chose pendant les deux guerres du Golf (Les années 1990).
Nombreuses étaient les familles qui voulaient donner le prénom Saddam à
leur progéniture, en référence à Saddam Hussein, l’ancien président de
l’Iraq (1979-2003), vu comme un résistant contre l’impérialisme et
contre les anti-islams.
L’histoire de Samuel avec ses deux
prénoms (Mohmmad et Samuel), très différents au niveau des
représentations culturelles et idéologiques, résume les multiples
dimensions qu’un prénom puisse avoir. À sa naissance, il portait le
prénom de Mohmmad. Par ce prénom, ses parents l’inscrivaient à la fois
dans la culture locale et au sein de la grande communauté musulmane.
Deux ans plus tard, ses parents adoptifs, Suisses et chrétiens, décident
de changer son prénom. Il devient Samuel. Par leur décision, ils
expriment un amour profond de leur enfant et une volonté de l’intégrer
pleinement dans la société suisse. Par le changement du prénom, on passe
ainsi d’une appartenance religieuse et culturelle à une autre7.
Au Maroc, comme dans toutes les sociétés
dites « arabo-musulmanes », le prénom doit aussi concorder à une
couleur. Un Samuel ne peut être que blanc aux yeux bleus. La réaction du
douanier marocain, qui vérifiait les papiers de Samuel (chrétien) tout
en regardant son visage bronzé (considéré conventionnellement comme
marocain), soulève cette problématique. Cela relève d’une certaine
représentation que les Marocains ont sur le prénom en rapport avec la
couleur. Il s’agit d’une identité marocaine imaginée et composée de
plusieurs éléments : L’islam, la couleur (généralement bronzée ou noir),
la langue (l’arabe ou l’amazighe), et le prénom arabe. C’est le
résultat d’un long processus de symbolisation de la Nation marocaine8,
centrée essentiellement sur l’islam et l’arabe. Ainsi, la diversité
religieuse, des prénoms et de la couleur est presque absente dans cette
représentation de l’identité marocaine9.
Samuel, dans son voyage en quête de ses
origines, fut confronté à ce problème complexe. Tiraillé entre son
prénom musulman et son prénom chrétien, il fut obligé de revenir à son
premier prénom, Mohamed, pour réintégrer sa société « d’origine ». Ceci
dit, d’autres personnes rencontrées à Agadir vivent des situations
relativement semblables à la sienne, au sein même de la société
musulmane. C’est le cas de Ziri. Contrairement à la tradition dominante
qui préfère les prénoms arabes (vus comme musulmans), ce jeune
réceptionniste dans un hôtel à Agadir, qui s’appelle administrativement
Bouhsin, a fait le choix d’un autre prénom, cette fois-ci, issu de la
langue amazighe : Ziri. Il représente ainsi une nouvelle tendance dans
le choix des prénoms, celle de jeunes gadiris qui désirent sauvegarder
l’amazighité d’Agadir en extériorisant leur identité amazighe. Porter un
prénom amazigh est devenu un acte militant.
Fadna, la cousine de Samuel/Mohmmad,
qui, elle aussi se prostituait à Agadir après avoir quitté son foyer
parental, n’a pas été épargnée par cette question. Son prénom est une
forme amazighisée du prénom arabe Fatima (prénom de la fille du prophète
Mohamed). Les Amazighes marocaines l’ont porté pendant des siècles sans
aucun complexe. Or, depuis quelques années, cette forme provoque aux
yeux des jeunes générations un sentiment d’infériorité. Pour les uns,
c’est un prénom montagnard et pour les autres, c’est une déformation
inacceptable d’un prénom musulman. Dans ce sens, Fadwa, la copine de
Fadna, influencée par le Wahabisme après son mariage avec un Saoudien,
persiste à appeler cette dernière Fatima.
Par tous ces exemples, nous remarquons
que le choix d’un prénom est fluctuant. Il reflète la nature des
influences culturelles d’une société et les conflits idéologiques entre
les différentes tendances en compétition pour la prédominance sur la
société marocaine, que ce soit au nom de l’identité locale, de la
religion musulmane ou de la mondialisation.
6- La langue : entre identité attribuée, identité vécue et identité revendiquée.
Depuis sa décision d’aller chercher ses
origines au Maroc, Samuel décide d’apprendre la langue de ce pays. Elle
ne pouvait être que l’arabe, étant donné que le Maroc, aux yeux
des Suisses (et des Européens en général), est un pays arabe. Il s’agit
là d’une identité attribuée, soutenue aussi par le Maroc qui se présente
dans ses discours officiels comme un pays arabe. C’est le début d’une
longue aventure linguistique. Samuel, avec l’aide d’un Marocain,
originaire de Casablanca, commence par apprendre l’arabe classique.
Arrivé au Maroc, il découvre la multiplicité des langues parlées. Une
telle diversité remet en cause l’image préétablie sur son pays de
naissance. Depuis le premier jour à Agadir, Samuel constata que l’arabe
classique pour laquelle il a consacré beaucoup de temps ne sert à rien.
Mis à part quelques mots de l’hôtesse de l’air qu’il a compris avec
joie, cette langue ne lui a pas facilité la communication avec les
Marocains. Face au douanier, il découvre l’existence de l’arabe
dialectal, très différent de l’arabe qu’il a appris en Suisse. De
l’aéroport à l’hôtel, sa souffrance continue. Le chauffeur du taxi lui
parlait dans une autre langue, l’amazigh et Samuel tout de même
répondait en arabe classique. Les quelques phrases qu’il a prononcées
deviennent un sujet de moquerie du chauffeur de taxi, qui considère que
Samuel, vu sa couleur et son aspect physique très marocain, ne veut pas
parler l’amazighe, la langue du pays. Là, c’est une autre identité qui
apparaît. Celle vécue mais exclue et qui sera ultérieurement
revendiquée. À l’hôtel où ce problème s’accentua une fois de plus,
Samuel décide de prendre les choses en main et cherche à comprendre.
Grâce à Ziri, le réceptionniste de l’hôtel mais aussi militant des
droits des langues dominées (dont l’amazighe), il va enfin comprendre la
diversité linguistique au Maroc, la hiérarchie des langues et surtout
la différence entre la langue de l’Etat et les langues du peuple. Cette
hiérarchie des langues provoque aussi une certaine hiérarchie des
identités liées à ces langues. En conséquence, un discours militant se
produit autour des langues dominées pour revendiquer l’égalité avec la
langue dominante.
7- L’islam : l’identité suprême.
Le parcours de combattant que Samuel a
parcouru pour arriver à Agadir et trouver les membres de sa famille
montre la centralité de l’islam comme repère identitaire majeur dans la
vision des Marocains au monde. Le retour au prénom Mohamed était pour
lui la porte s’ouvrant sur un monde complexe où se mêlent des pratiques
différentes, quelques fois contradictoires. Elles s’ajoutent à
l’idéologie et au politique et se présentent sous un seul mot : la
religion. La rencontre de Samuel avec Fadna, sa cousine, était en
réalité une entrée dans ce monde nouveau, plein de contraintes et
d’obstacles à surmonter. C’est le prix que Samuel doit payer pour
retrouver son identité perdue. Contrairement à la tradition au Maroc,
Samuel, aux yeux de sa cousine (et via elle la société marocaine) n’est
pas musulman ni par son prénom d’origine, ni par sa naissance au Maroc,
ni par ses parents qui étaient des musulmans. Il doit en quelque sorte
se convertir en faisant une série de rites pour confirmer son islam. La
formule initiale « achahadatayn », par laquelle les non musulmans
déclarent leur conversion en islam, était pour Samuel simple et ne
demandait pas beaucoup d’effort (p.103). De même pour le mariage avec
Fadna par la fatiha, première sourat du Coran. Pour gagner l’amour de sa
cousine et l’intégration dans la société marocaine, Samuel était prêt à
faire des sacrifices. Il accepta de faire la prière, cinq fois par
jours et de ne plus boire d’alcool, lui qui aimait se faire plaisir en
buvant quelques bières. Mais, hélas, malgré tous ces sacrifices, l’islam
de Samuel est aux yeux de Fadna incomplet. Elle lui avance qu’il
n’existe pas de musulman non circoncis, (même s’il fait la prière
(p.75-124).Une vraie épreuve pour Samuel. Par amour, il accepte de se
faire opérer. Mais, contrairement à ses attentes et aux attentes de sa
cousine, une erreur chirurgicale empêcha toute possibilité d’une
érection. Il devint ainsi impuissant.
8- L’érection : la qualité suprême d’un homme ?
Animé par une grande volonté d’intégrer «
sa » société d’origine, qui passe par un amour fou de Fadna, sa cousine
retrouvée, Samuel accepta toutes les exigences de Fadna, pour qu’il
soit l’homme parfait de sa vie, selon les critères de la société
marocaine musulmane. Hélas, son impuissance changea complètement la
position de sa cousine. Si elle lui a avancé au début qu’un vrai
musulman doit absolument être circoncis, elle trouve encore dans la
religion la raison pour se séparer de son mari à cause de son
impuissance. L’islam incite les musulmans à se reproduire pour être plus
nombreux que les infidèles, justifie Fadna. Et ce ne pourra se faire
qu’avec un musulman puissant. Cette position, comme d’ailleurs les
précédentes, était incitée par Fadwa. Elle a réussi à transformer la
vision de son ancienne copine à la vie et à la religion. Fadna adopta
aussi une vision obscurantiste, mit la burqua et finit par demander le
divorce à Samuel. Devant l’impuissance de ce dernier, tous les autres
critères (le prénom, la formule de chahadatayn, la prière, la
circoncision), considérés au début comme des obligations religieuses,
perdent leur valeur. Malgré ses sacrifices, Samuel fut rejeté par sa
cousine et via elle par la société. Après avoir perdu une autre fois
l’une de ses qualité, l’érection, qui résume même son identité, il
décide de quitter la maison et alla chercher son oncle dans les
montagnes d’Ida Ou Tanan, aux alentour d’Agadir.
9- La montagne : est-il le refuge éternel de l’identité amazighe ?
La rencontre avec Fadna était l’ultime objectif de Samuel dans son voyage à Agadir. Grâce à un réseau de prostituées, il la rencontre dans un bar. C’est la retrouvaille après plus de deux décennies de séparation imposées par le tremblement de terre d’Agadir. Cette même tragédie a poussé son oncle Dda Soid à s’éloigner de la nouvelle ville reconstruite, mais qui ne garde rien de l’ancienne ville. Samuel, malgré ses efforts déployés pour intégrer sa société « d’origine » qu’il a quittée, lui aussi, à cause du tremblement, se trouve aussi rejeté par la nouvelle ville. Il rejoint son oncle, qu’il a réussi à trouver dans une tribu au alentour d’Agadir : les Ida Ou Tanan. Comme son oncle, c’est au milieu d’un village, isolé au sommet des montagnes, qu’il s’est senti chez lui. Deux générations différentes décident de quitter la ville moderne d’Agadir pour aller chercher une identité perdue au milieu des montagnes. S’agit-il d’un sentiment de perte de la ville alors que l’auteur d’Ismdal n tmagit se présente comme le romancier de l’amazighité citadine ?Dans ce dernier refuge, Mohmmad (ancien Samuel), qui a hérité de son oncle après sa mort, se présente comme porteur d’un message de tolérance, de liberté de penser et de diversité. Entouré par une dizaine d’enfants, il leur avance ces expressions : « Ad akk ihrcn a tarwa d iv kullu gan middn yan, mllulen kullu nv sggann ak, gaddan v tvzi, gaddan v turrut, ar ad ccttan yat tirmt, ar ak ssan yat tissi. Macc ad ak bahra ihrcn a tarwa d iv ur ar swingimen, adjn wiyyad ad swingimen v umras-nsn » (pp.161-162). « Mes enfants ! La pire des situations serait que tous les êtres humains soient semblables : tous blancs ou tous noirs, tous grands ou gros, qu’ils mangent et boivent tous la même chose. Pire encore, qu’ils ne réfléchissent pas eux-mêmes et laissent les autres réfléchir à leur place ».
Par Lahoucine Bouyaakoubi
1 Brahim Lasri Amazigh, Ijawwan n tayri, publication de l’association Imal de Marrakech, Idgl, 2009.
2 BOUYAAKOUBI Lahoucine, « Ijawwan n tayri, un sujet tabou dans une langue taboue », in www.amazighnews.net
3 Les preuves ne manquent pas pour montrer que dans cette région de l’amazighophonie, écrire en amazighe est une tradition très ancienne, qui a continué, presque sans interruption, depuis au moins le Moyen-Âge. Elle concerne essentiellement les manuscrits, les actes notariaux, les lois ou la traduction des textes religieux. Pour plus de détails voir par exemple : Les manuscrits berbères au Maghreb et dans les collections européennes, Actes des journées d’études à l’initiative du Centre de conservation du livre, dans le cadre du programme MANUMED et de l’Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman (IREMAM), Aix-en- Provence, 2002.
4 A ce jour, presque 25 romans en amazighe sont publiés au Maroc.
5 MONTAGNE Robert, « Un magasin collectif de l’Anti-Atlas, l’agadir des Ikounka », Hespéris, IX, 1929.
6 Il ne s’agit pas de faire allusion à Agadir Oufella, la casbat qui existe encore à Agadir, mais de soulever la question des pertes qu’un tremblement de terre peut provoquer sur la culture de la région concernée.
7 Notamment après avoir considéré tous les prénoms arabes comme des prénoms musulmans. Dans ce sens, une tradition s’est imposée et ayant même une connotation religieuse. Il s’agit de changer le prénom après chaque conversion à l’islam. Ainsi, on demande à un certain Tony ou Bernard convertis à l’islam de changer son prénom pour qu’il devienne Mohamed ou Mehdi.
8 Expression inspirée du titre du livre de Hassan Rachik intitulé, Symboliser la Nation, essai sur l’usage des identités collectives au Maroc, Le Fennec, 2003.
9 Seule la diversité linguistique (arabe et amazighe) est relativement admise, avec une certaine faveur pour l’arabe, langue du Coran et donc de l’islam. On peut même comprendre qu’un musulman doit forcément être Arabe.

 0 comment
0 comment
ixfawn d isasan
ngh iswingimen ikkerfn ixf ;
arra amzwaru n tflsaft tamazight
s tmazight
==============
Adlis
n ixfawn d isasan lli-d issufgh Mohamed Oussous iga yan warra isawaln f
tmukrisin n tmagit d uswingm n ddin d taydyulujiyin illasn lli ikrfn
anlli d twngimt n ufgan amazigh, ism ns iga snat tguriwin:
1-ixfawn: iguyya, macc ur-d iguyya iqqurn nv-d iqllaln, macc ira ad yini: tawngimt, anlli, imiss lli s iswingim ufgan.
2-
isasan: mnnaw n isisi, igat uzttâ n tbghaynust, ira ad yini s tguri ad,
iskraf lli ittassn aswingm n ufgan, kksn as ad iswingm s tgharast
ifawn, skucmnt, ngh as ssfrghn aswingm d usmmaqql, zund aswingm ngh
taydyulujit n “t3rabuslamt” lli nn ittqqnn afgan s tsrgwlt n ti3urrba.
arra
ad tssfught id tmsmunt tamaynut, iga 104 n tudmt, ilin gis 36 n umagrad
(articles) d yat tzwart lli as iskr usalmad Muhmmad Akunad, ig-t umara
ns d trzzift I umazzal amazigh
amqqran ali sidqi azayku, ittyara s tmazight n sus ifawn ighusn, lli-d
ittasin tiguriwin zg ku tasga n tmizar n tmazgha. ar immal ma s tzdâr
tmazight ad tasi aswingm aflsaf, tara f imukrisn n uswingm mknna gan,
adlis ad ilmma iga yan wanaw n tirra urta jjin gis uran imazighn, acku
tugt n aylli-d ittffaghn ar ghilad ur ar ittffagh asays n tskla, ur jjin
kcmn imazighn igran yadên n tussna s wawal nnsn, mayann af iga udlis
amzwaru gh wanaw ns, ar d issaggwa ma mi tzdâr tmazight gh ku asays gh
isuyas n tussna d uswingm.
inna umara n udlis ad g uskcm ns:
“Arra yad ur igi amarg, ur igi taflsaft, ur igi tallasin d umiyn, ur ssngh nkki s ixf inu ma yga! Mac ssngh is gis kra n tmqqa n iswingimn, ad d ukan uffnt g ixf inu, ar ttaddumnt, ar asnt ssmdaygh timkilt n tirra, krfgh tnt mqqar ur nnigh ayamar i yskraf!
Iskkiln lli gis illan gan igdâd, rwln d zg ignna n ul inu, d unlli inu, gwmrgh tn, ggh tn g izîtî n tguriwin!
Righ
gis ad ig uggar n tirra nna aqqrant walln ur smussnt anlli, acku arra
nna tghrit ur ak d issuss kra n ikwdrâr d isasan n ixf nk, ur ak irwi
tagharast lli s tsnit tazra n tudrt, ur ak izluzzi amk lli s tgwnit tighawsiwin gh iswingimn nk, han ur akw bahra yuf awal n iwssarn ddu ighrban s tissi n watay d waqqayn n trufin!”
ha yan umdya n imagradn n udlis ad:
Ixf n tawwukt d win ighirdem
Max ur ili ighirdem ixf?
Ar
ittini yan umiy amazigh is d lligh ar yattû ugllid imqqurn ixfawn,
iggwra nn ighirdm, ur iddi zikk ad d yawi ixf ns. g ubrid n twada ns,
inmaggar tawwukt, inna yas: "is sul ghaman ixfawn?", trar as d: "yan ixf zund winu ad sul ighaman! " yadû d nit, ur sul idêfr agharas ad d yawi ixf ns, inna yas: "igh iyi d iqqan ixf igan zund winm, yuf war ixf!";
iqqim ilmma ighirdm d war ixf. Yan innan tawwukt, ar d iktti ixrtuffa d
iqwirn d imrduln, ar as d ittikwcâd ixf ns tillas, ixf n tawwukt ilmma
iga dari tamatart n uswingm illasn, aswingm ittawin s urwass!
Ini nit tamttant n uswingm, d ubukêd n tayttî d ukttur n malxf d unlli s gar iswingimn!
Igh d iqqan ad isti yan gr ad yili ixf n tawwukt (aswingm n tillas) d ad akw ur ili ixf, yuf ad ig war ixf!
 0 comment
0 comment
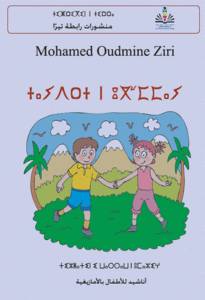
تايدرت ن ؤكماي: مجموعة أناشيد امازيغية للشاعر محمد ادمين
صدر
مؤخرا مجموعة أناشيد للأطفال تحت عنوان “تايدرت ن وكَماي ” للشاعر محمد
ادمين زيري، ضمن منشورات رابطة تيرا للكتاب والمبدعين بالامازيغية بمطبعة
سونر امبرموري ايت ملول سنة2012 .
والمجموعة الشعرية من الحجم المتوسط كتبت أناشيدها بالحرف الامازيغي تيفيناغ وتتكون من ستة وثلاثين (36) صفحة وتضم ستة عشر (16) نشيدا، مزينة برسومات توضيحية بالأبيض والأسود .
أما العنوان فيجمع بين كلمتين تايدرت taydrt التي تعني السنبلة وهي الغلة والمحصول وagwmmay أي التهجي وتعلم القراءة وبذلك ف taydrt n ugwmmay تعني سنابل التهجي وبمعنى أوضح حصيلة القراءة.
أما الغلاف فباللون الأزرق السماوي المائل إلى الرمادي في دفته الأولى كتب بالحرف العربي وتيفناغ واللاتيني اسم الرابطة واسم الشاعر وعنوان المجموعة وأناشيد للأطفال بالامازيغية ويتوسط الغلاف رسم أو لوحة لطفلين يتنزهان في حديقة جميلة . وفي الدفة الأخيرة كتب نشيد ” agDiD n eZiTi”.
ومن أناشيد الديوان : تافوكت، انزار، تاكَمات، تمازيغت، اسكَاس، كوز يميرن، اشنيال امازيغ، تازويت، اكَضيض ن يزيطي، اتبير، لوطار د ريباب، يض ن يناير، ويزوكَن د وطوف، تاجديكت تازواواغت، يتران د وايور، ادليس.
وفي نشيد “اكَضيض ن يزيطي agDiD n iZTi ” صفحة 19 يقول الشاعر:
A agDiD amzyan
Manza giwn aZawan
iZiTi nna lli v tllit
ad k igan d ugacur
awrayat a tifrxin
ula knnin a ifrxan
ad nRZm i waylal
ad iffarri s ignwan
ad iddu dar ait mas
iddr tudrt lli ran
والشاعر محمد ادمين الملقب ب زيري اعلامي امازيغي مشهور ببرامجه الإذاعية الشيقة، سبق أن نال جوائز في مسابقات الأنشودة التربوية باكادير كما صدر له ديوان شعري سنة 2005 تحت عنوان ‘اورفان / الحصى الملتهبة” .
والمجموعة الشعرية من الحجم المتوسط كتبت أناشيدها بالحرف الامازيغي تيفيناغ وتتكون من ستة وثلاثين (36) صفحة وتضم ستة عشر (16) نشيدا، مزينة برسومات توضيحية بالأبيض والأسود .
أما العنوان فيجمع بين كلمتين تايدرت taydrt التي تعني السنبلة وهي الغلة والمحصول وagwmmay أي التهجي وتعلم القراءة وبذلك ف taydrt n ugwmmay تعني سنابل التهجي وبمعنى أوضح حصيلة القراءة.
أما الغلاف فباللون الأزرق السماوي المائل إلى الرمادي في دفته الأولى كتب بالحرف العربي وتيفناغ واللاتيني اسم الرابطة واسم الشاعر وعنوان المجموعة وأناشيد للأطفال بالامازيغية ويتوسط الغلاف رسم أو لوحة لطفلين يتنزهان في حديقة جميلة . وفي الدفة الأخيرة كتب نشيد ” agDiD n eZiTi”.
ومن أناشيد الديوان : تافوكت، انزار، تاكَمات، تمازيغت، اسكَاس، كوز يميرن، اشنيال امازيغ، تازويت، اكَضيض ن يزيطي، اتبير، لوطار د ريباب، يض ن يناير، ويزوكَن د وطوف، تاجديكت تازواواغت، يتران د وايور، ادليس.
وفي نشيد “اكَضيض ن يزيطي agDiD n iZTi ” صفحة 19 يقول الشاعر:
A agDiD amzyan
Manza giwn aZawan
iZiTi nna lli v tllit
ad k igan d ugacur
awrayat a tifrxin
ula knnin a ifrxan
ad nRZm i waylal
ad iffarri s ignwan
ad iddu dar ait mas
iddr tudrt lli ran
والشاعر محمد ادمين الملقب ب زيري اعلامي امازيغي مشهور ببرامجه الإذاعية الشيقة، سبق أن نال جوائز في مسابقات الأنشودة التربوية باكادير كما صدر له ديوان شعري سنة 2005 تحت عنوان ‘اورفان / الحصى الملتهبة” .
محمد أرجدال
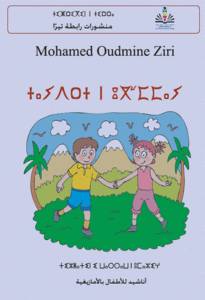
 0 comment
0 comment
gr igiwal n taba
قصص للأطفال لمحمد كارحو
محمد أرجدال
صدرا مؤخرا للكاتب الامازيغي محمد كرحو مجموعة قصصيةخاصة بالأطفال تحت عنوان " كر يكوال ن تابا /gr igwal n taba " ضمنمنشورات رابطة تيرا للكتاب والمبدعين بالامازيغية ، بمطبعة سونتر امبريموريبايت ملول سنة 2012 وبهذه المجموعة القصصية نال الكاتب جائزة "رابطة تيرا" للإبداع الكتابي صنف أدب الطفل لسنة 2012 إلى جانب كتاب آخرين.
وهذهالمجموعة القصصية من الحجم الصغير كتبت نصوصها القصصية بالحرف الامازيغيتيفيناغ ، وبالنسبة للغلاف الخارجي فتعلوا دفته الأولى لوحة من تصميمالفنانة التشكيلية مليكة حوزيك كلداسنت وتمثل سيدتين بلباس تقليدي إحداهماتحمل في يدها قبضة من سنابل القمح وكتب عليها بالحروف الثلاثة الامازيغيوالعربي واللاتيني اسم الكاتب والعنوان وصنفه واسم الرابطة ، أماالدفةالأخيرة فكتبت عليها أقصوصة من المجموعة ,
تتألف مجموعة gr igwal n taba للأطفال من أربعة عشر(14) قصة وتضم حوالي أربعون (40) صفحة، وعناوين النصوص القصصية هي:
حمادد مروهو / احمد والدعسوقة ، افولي ن وزعضوض / جمال القرد، تزانت د وموشني/ الطفل وقطه ، تيدوكلا ن ويدي/ صداقة كلب ، تاقجداوت، اتبير غ تينمل / الحمام في المدرسة ، ورارن ن وغردا د وموش / لعبة الفأر والقط ، تسنانت ن تكناريت/ اشواك تمارالصبار ، تاوري ن ومكراز/ أعمال الفلاح ، ورار ن يغوياين / لعبة يغوياين، يزمي ن وركان / عصارة الأركان ، انكَاس/ الحادثة،ازان يفركن يماس د باباس ، تكمارت ن يسمضال
يقول الكاتب في اقصوصة "tazzant d umucc ns " :
وهذهالمجموعة القصصية من الحجم الصغير كتبت نصوصها القصصية بالحرف الامازيغيتيفيناغ ، وبالنسبة للغلاف الخارجي فتعلوا دفته الأولى لوحة من تصميمالفنانة التشكيلية مليكة حوزيك كلداسنت وتمثل سيدتين بلباس تقليدي إحداهماتحمل في يدها قبضة من سنابل القمح وكتب عليها بالحروف الثلاثة الامازيغيوالعربي واللاتيني اسم الكاتب والعنوان وصنفه واسم الرابطة ، أماالدفةالأخيرة فكتبت عليها أقصوصة من المجموعة ,
تتألف مجموعة gr igwal n taba للأطفال من أربعة عشر(14) قصة وتضم حوالي أربعون (40) صفحة، وعناوين النصوص القصصية هي:
حمادد مروهو / احمد والدعسوقة ، افولي ن وزعضوض / جمال القرد، تزانت د وموشني/ الطفل وقطه ، تيدوكلا ن ويدي/ صداقة كلب ، تاقجداوت، اتبير غ تينمل / الحمام في المدرسة ، ورارن ن وغردا د وموش / لعبة الفأر والقط ، تسنانت ن تكناريت/ اشواك تمارالصبار ، تاوري ن ومكراز/ أعمال الفلاح ، ورار ن يغوياين / لعبة يغوياين، يزمي ن وركان / عصارة الأركان ، انكَاس/ الحادثة،ازان يفركن يماس د باباس ، تكمارت ن يسمضال
يقول الكاتب في اقصوصة "tazzant d umucc ns " :
Tusi d tazzant afcku nns tg d gis imik n tudit , tfk t i umucc nns , yawn as ar lliv tt akkw illv , issfD imi nns ar nit dav ismi33iw tZwi as dav imik n tfyya , v uruku inv dis laz nns iskkus v imi n tgmi izzl gis idarn nns, isqqndl s tafukt ar as tkkmz tazzant iggi n ixf nns, tssfsi alvf nns s tayri nns, imlldi dis ula nttan tayri , ur sul izDaR ad dids yingara, lliv tgn tazzant ign umucc ula ntta v tama nns

 0 comment
0 comment
قراءة في رواية تمورت ن الفاون
Tamurt n ilfawn
للكاتب محمد أكوناض
بقلم محمد أيت بود
تعتبر رواية "تامورت ن ئلفاون" الروايةالثالثة في مسار الأستاذ محمد أكوناض، المبدع الرائد في صنف الروايةالأمازيغيةبلا منازع، ذلك المسار الذي نعرفجميعا أنه لم يكن أبدا مفروشا بالورود، بل هو مسار شاق ومضن في سياقالتحولات الكبرى التي تعرفها القضية الأمازيغية، في علاقتها الجدليةبالمجالات المرتبطة بها، وبالأخص ماله علاقة بالتحول نحو ترسيخ تقاليدالكتابة في مجتمع كان الى الأمس القريب مجتمعا يغوص في أعماق التراث الشفهي، وكذا بالتحولات السوسيولوجية للمجتمع المغربي بصفة عامة ،الآخذ فيالتحول من مجتمع قبلي زراعي، الى مجتمع مدني صناعي ،في هذا السياق ، جاءتالرواية التي بين أيدينا ، زاخرة بالمعاني والثيمات المصاحبة لهذه التحولاتالقيمية ، ناضحة بالتمثلات المرافقة لفكرة التحول في حد ذاتها من حيثكونها ، تعني الانتقال من وضع معين الى وضع آخر ، هذا التحول العنيف الذييشهده المجتمع المغربي عامة والأمازيغي خاصة ، المتأثر بعدة عوامل ، منهاما هو داخلي ومنها ما هو خارجي ،لا شك سيخلف وراءه آثارا عميقه ، وخدوداغائرة ، من حيث سعيه الى اجتثاث الانسية المغربية من عمقها التاريخيوالأنثروبولوجي ، وزرعها في تربة الحداثة الفكرية والسوسيولوجية ،في هذاالسياق المتلاطم ، وغير المستقر ، أهدانا الكاتب ، جوهرة ثالثة من جواهرعقده الذهبي ،ذلك العقد المزدان بحرقة التساؤل ، وقشعريرة التمثل ،والفائرببركان التأمل والتجريد العميق ، المرافق للطقس الصوفي المشبع بالاستيهامالمستوحش ، والمخترق للفضاءات والأزمنة المحرمة كهنوتيا ، والملامس لحراشيفالطابوهات المتجذرة في أعماق الانسية المغربية والأمازيغية ، انها الروايةالتي تنتشي بكأس الانتصار ، ... أعني الانتصار لكل القضايا السالفة ، فيهاركب الكاتب صهوة التعبير الأدبي الشيق ، بلغة أمازيغية صوفية ورشيقة ،تنهلمن المعجم الأمازيغي الرابض في تكلسات الألسن الشفهية للتنويعات اللهجيةفي مختلف مناطق المغرب ولم لا لعموم تمازغا أيضا ، معجم يمتح من المرادفاتالأصيلة ، كما ينهل من المرادفات المستحدثة ،في محاولة من الكاتب ، وقد وفقبنجاح منقطع النظير في كتابة نص أدبي شيق ، يجمع بين خاصيات النص الأدبيوخاصيات الكتاب الفلسفي ، الذي يحمل بين طياته الكثير والكثير من الأسئلةالحارقة والمحيرة ، فشكرا مرة أخرى لأستاذنا على هذه الجوهرة اللامعة ،والتي لاشك في كونها سوف تضيئ عتمة اللغة والثقافة الأمازيغيتين في تضاريسالمسار الشاق والصعب الذي تسلكانه برفقة المبدع والمغامر بامتياز ،الكامنفي أعماق محمد أكوناض .تانميرت أطاس .
مقاربة النص الروائي:
لاشكأن مقاربة عالم الرواية التي بين أيدينا من الناحية المنهجية يعد أمراليس بالهين ، بالنظر الى ثرائها الموضوعاتي ، وتعدد مكوناتها وأنساقها وكذامستوياتها النصية ، لهذا أجد من الصعوبة بمكان الاحاطة بكل عوالم هذهالرواية وأسرارها من خلال زاوية نظر معينة ، وهذا الأمريطرح اشكالية تعددمستويات قراءة النص الروائي بصفة عامة ، وبما أن القراءة يجب أن تنطلق منمنهج نقدي يعتمد على مفاهيم و أدوات في التعامل مع هذا النص أو ذاك ، فانالمناهج النقدية تتعدد بدورها بتعدد زوايا النظر التي ينطلق منها الناقد ،لذلك ارتأيت أن أقوم بعملية قراءة للنص الذي بين يدي باعتماد الياتتحليلية أو بالاعتماد على آليات القراءة التحليلية والتركيبية في نفسالآن ، والتي تعتمد على المراحل أو المكونات الآتية :
مكونات النص، الرهان دلالات وأبعاد الحدث:
يتكونالنص الذي بين أيدينا من مكونات متعددة ، لغوية ، شخصيات ، أسماء الأماكن ،فضاءات واقعية وأخرى متخيلة ، أنساق سلطوية ...الخ ، رهان السارد في ذلكمحاولة نقل صورة محايته ومحاكية للواقع ، الى حد ما لمجتمع يعج بالتناقضات ،هو قيد التحول ، فضمن الفصل الأول يستعرض الكاتب بطل الرواية الذي هو " بيهي ن وايشون " وبيهي اسم علم شخص محرف من الأصل الذي هو ابراهيم ،ليصبح على نحوما جاء في الرواية أي " بيهي " وهو اسم علم شائع في جل مناطقسوس بهذه الصيغة المكيفة مع الصيغة اللغوية المحلية بمنطقة سوس ،والتحريفالذي لحق اسم بطل الرواية قد ينطبق على كل الثيمات والوقائع والأحداث التيزخر بها النص والمتن الروائي ، انها تيمة التحريف ، تعد لازمة العملالروائي من مبتدأه الى منتهاه ، تحريف أسماء الأماكن ، تحريف ارادة الناسالبسطاء ، تحريف هويتهم ،...الخ ، وبطل الرواية وقعت له حادثة مفادها رؤيتهلشاحنة كبيرة تفرغ حمولتها من الخنازير البرية في الغابة المجاورة للبلدة، وهي منطقة اختار لها الكاتب اسم علم :" أيت اوروكو " وهو اسم علمبالرغم من كونه يمتح من اللغة الأمازيغية ، الا أننا لا نعرف ما اذا كانعلما واقعيا يوجد في الطوبونيميا الجغرافية للمغرب أو علما متخيلا ،ومحاولة اخبار أهل البلدة أو الدوار بما رآه ، وعدم تصديقهم له بداية الأمر، دلالة على عدم استعداد الناس لتقبل بعض الحقائق التي سرعان ما تتحول الىواقع مرير ، هذه الجزئية تحيل على قصة روسية مترجمة الى اللغة الأمازيغيةمنشورة لأحد القصاصين الشباب بمجلة تاماكيت التي كانت تصدر في سنواتالتسعينيات من القرن الماضي ، بمدينة أكادير ، بعنوان " توتلايت ن تسغيولت " ، تلخص القصة ، مسألة الهاء الذات وتسليتها بالكذب عليها ، وابعادالحقائق المريرة الماثلة أمامها ،كون الحمار في الأقصوصة آخذ في الهاء نفسهبكون الخطر المتمثل في ذئب شرس آت ليفترسه لايزال بعيدا عنه ، فين حينيراه هو قريبا جدا منه ،... وهكذا دواليك حتى أطبق عليه الذئب....الخ ،يفسر الذهنية الانتظارية السائدة في المجتمع المغربي ، خاصة في البادية ،وعدم السعي الى المبادرة لدرء المخاطر المحدقة ، بالنسبة لسكان دوار " أروكو " الخطر المحدق والذي أصبح حقيقة يعيها الجميع بعد حين ، هي أنالسلطة الزمنية ، والتي سماها الكاتب :" المخزن " ، قد قامت بإفراغ حمولةمن الخنازير البرية في محيط الدوار ، هذه التسمية وردت في متن الروايةلأزيد من 30 مرة ، تبين مدى فداحة الفعل الذي أقدمت عليه بالنسبة لأهل :" أروكو " من جهة ، كما تبين ، التلميح القدحي ، للرفض المختلس في أعماقالكاتب لسلوكيات هذه المؤسسة السلطوية ، والتي يمثلها شيخ القبيلة " أمغارأوبوهو " ، والذي يجسد الحضور السلطوي الكثيف للسلطة الزمنية المسماة " المخزن " ضمن نسيج المجتمع القبلي والبدوي ، بالمغرب ، في سياق منفصل ،ولكنه وارد ضمن نفس السياق الرافض لمسألة افراغ الخنازير بمحيط بلدة " أروكو " ، محاورة بين شاب ، متعلم مع " أمغار أوبوهو " ، والاحتجاج بمقولةحقوق الانسان ،المبنية على المر تكز القانوني والحقوقي ، المناقض لمقولة" المخزن" المبنية على البطش والكيد وعدم الانصات ، خطاب في مستوى مختلفاراد من خلاله السارد أن يظهر جسامة الاختلالات البنيوية الفكرية والثقافيةالماثلة في خضم التناقضات التي يعج بها دوار جبلي اختار له الكاتب اسم " أروكو " ، كمثال على واقع المغرب الخلفي الرابض في اسار الجهل والتخلف ،والمنصت لآهات التشنج السلطوي والعنف الرمزي الممارس عليه من طرف السلطةالزمنية ، بكثير من التلذذ والاستسلام ، بل والتبرير أيضا ، ومحاورة الشابوالشيخ غير المتكافئة من الناحية الفكرية ، تبرز ، ليس أزمة الجهل والأمية ،فحسب ، بل وايضا جدلية تناقض الأجيال المتعارف عليها بصراع الأجيال ، بيدأن الشيخ " أمغار " وانطلاقا من ذهنيته البسيطة ، قام بعقد مقارنة بينمقولة الشاب حول حقوق الانسان وقصص الجدات التي تحكيها للأحفاد ، متوجااياها بمقولة " بومحند " في نفس القصة المعروفة في الحكي الشفهي :" بقصةبومحند" ، عندما وضع عليه الاناء الذي يصنع به الكسكس ، أي الكسكاس،حسب التعبير المغربي ، بحيث قال : " أتيفاوت أور تحودي ئمي أورتات أوفيغ " ، في اشارة منه الى أزمة خطاب حقوق الانسان نفسه الذي تتبناه الطبقاتالمثقفة ، والمجتمع المدني ، وحتى الدولة نفسها.وفي مستوى آخر و بالرغم منكون أهل البلدة ، عبروا عن رفضهم لهذا الفعل ، من حيث كونه يضر بزراعتهم ،وممتلكاتهم ، غير أن السلطة لم تنصت لاحتجاجهم بل وقامت بقمع كل تحركاتهمالرافضة لعملها ، وفي خضم ذلك تم سجن " بيهي ن وايشون " من حيث قيامه بقتلأحد الخنازير البرية وأكل لحمه ، ... السلطة قامت بإحضار عدة لجان الىالبلدة ، لتفسير وتبرير فعلتها في أعين السكان واضفاء الشرعية على عملها ،سواء بواسطة مسألة الاجتماعات التي تعقدها لأعيان القبيلة والقبائلالمجاورة ، من أجل مناقشة المشاكل المطروحة ، مثل الرعي ، توزيع المياه ،تنظيم الحراسة ... الخ ، في نفس السياق وعندما كان "الدكتور حنفي" وهو أحدالوجهاء المنتمين لدوار " أروكو " يشرح سياسة الدولة وأهدافها فيما يخصالغابات والبراري ، ومصادر المياه ، وكيف أن المشاكل تنبع من عدم استيعابالناس خاصة في " أروكو " والدواوير المجاورة له مثل " توكاومان أو ئوزيون " للغايات النبيلة للدولة المتمثلة في الحفاظ على البيئة والتنوعالبيولوجي ، يتباذر الى ذهن القارئ ، السؤال التالي :" هل كانت الدولة ،التي كثيرا ما عبر عنها الكاتب بتسمية " المخزن " ، بكل ما تملك من وسائلالضغط والاكراه المادي والرمزي في حاجة الى كل هذه الامكانيات لتشرح للناسفي قلب دوار جبلي نائي سياستها في مجال البيئة والتنوع البيولوجي ، من طرفاناس متضلعين في فن الكذب على الذقون ؟ لكن نفس السؤال يمكن أن يطرح بصيغةمختلفة كالآتي : ألم يكن هؤلاء الوجهاء المنتمين لهذه الدواوير الفقيرةوالمعدمة الرابضة في أعماق الجبال المنسية ، والمتنكرين لأبناء جلدتهم ،الا الوجه الآخر للسياسة المخزنية المرفوضة من طرف الأهالي ؟
القوى الفاعلة في الرواية :
داخلالنص تتفاعل مجموعة من القوى ، يتأثر بعضها ببعض ، يناقض بعضها البعضالآخر ، يحاول بعضها اقصاء البعض الآخر ، هذه القوى تتمثل في الأهالي الذينيقطنون الجبال والمرتفعات النائية ، المحاذية للمجال الغابوي ، والدولة أوالمخزن بتعبير الكاتب ،التي تعتبر أن الغابات والجبال ومصادر المياهوالبراري والوحيش ، وحتى الناس ، أي القاطنون للمجال ، ...الخ كلها ، وسائلتدخل في استراتيجية تدبير المجال ، أي الهامش ،بكل ما يحف به من تناقضات ،لاتعير السلطة بالا اليها ، الا عندما تريد استخدامها بما يعود عليهابالنفع ،أو الا عندما تريد اخضاعها ، يتجسد ذلك في المقولة الشعبية التيمعناها أن يد المخزن طويلة ، وتطال كل شيء ، و من يبحث عن المخزن لا يجده ،لكن المخزن اذا أراد شخصا وجده على الفور ، اشارة الى الباع الطويل للمخزن، في الوصول الى المناطق والأشخاص المرغوبين مهما كانوا بعيدين عنه ، ... بالإضافة الى هتين القوتين الكبيرتين والمتناقضتين ، والتي تضم كل واحدةمنهما مجموعة من الأدوات والآليات التي بواسطتها تحاول التأثير على الأخرى ،ومحاولة اخضاعها ، توجد قوى جانبية ، مثل قوى الخير والشر ، المتعارفعليهما في كل التجارب الانسانية ، تتجسد الأولى في ذلك الجانب الانسانيالكامن في أعماق كل شخصية على حدى مهما وصل شرها عنان السماء ، بالإضافةالى الجانب الايماني أو المعتقد الذي بدا في الأول مخلصا ، ليتحول مع بطلالرواية " بيهي ن وايشون " الى كابوس حقيقي ، خاصة محاولة استغلال التجربةالتي مر بها في السجن ،من حيث مراراتها للتأثير في شخصيته وقرار اته ،واخضاعه لرغباتها وأفكارها المسبقة عن الحياة والكون ،مع أفراد الجماعةالدينية الذين حاولوا التأثير على عقله من خلال بث العديد من الأفكاروالمقولات التي تستند الى الايمان والميتافيزيقيا من أجل ، انتاج أتباعمخلصين ، طيعين ، ينفذون الأوامر بدون أن يناقشوا فحواها ،... أراد من خلالهذه القوى الكاتب أن يبرز جانبا من الجوانب الخفية ، الفاعلة والمؤثرة فيالفعل الاجتماعي بالبادية المغربية ، كمجال يتفلت من التجربة الدينيةللدعاة " المحترفين " والجماعات الدينية الممتهنة لاسترقاق العقل البشري ،المفطور على الحرية ونبذ كل أشكال الوصايات ، خاصة الذهنية الأمازيغية فيالمناطق المهمشة ، والتي يتراوح ايمانها بالغيب بين التسليم واليقظة ، فيحين يتجسد الشر في قوى الاستغلال البشع لعقول الناس ومعتقداتهم من اجل الزجبهم في متاهات ، ومسارات مغلقة ، ثمة قوى أخرى تتجاذب داخل النص ، هي قوىالمعتقدات الشعبية ، التي تنهل من الفكر الخرافي للأضرحة والقبور ، يرمزالى ذلك في متن الرواية زيارة ضريح " لالة ديهيا " من طرف " اجا " زوجة " بيهي ، سبع مرات ، وحكاية السوار المعوج الذي رأته في الحلم ، والدجاجالأحمر اللون الذي أخبرت به زوجها أنها قامت بذبحه في الضريح ، وقرطاسالشمع الذي أمرت بإنارته في الضريح حتى الصباح ، الى جانب ذلك رؤية " بيهي " بدوره نفسه في الحلم في بحيرة " حيحا " ، اسم علم له عند الأهالي دلالةرمزية ، تحيل على القوى الخفية ، والخوف ، وقوى الشر التي تضمر الهلاك لبنيالبشر ، وهو يكف ملابسه ، متكأ على سلاح ، واقف على رجل واحدة، يضرب كل منيقترب من البحيرة ليشرب منها ،هذا المتن يحيلني ، على انطولوجية الأحلاملدى جاستون باشلار ، في كتابه الذي يحمل نفس الاسم ، وكيف تستطيع الأحلامأن تؤثر في أفعال البشر في اليقظة ، وكيف تتحول من أحلام الى أفعال واقعية ،.... جاء في متن الرواية ضمن القوى الفاعلة ، ذكر مسألة القضاء والقدرللتخفيف من معاناة أهل دوار " أيت اوروكو " بغياب " بيهي " عنهم ، بعداعتقاله ، والحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذة ، وفشل كل المحاولات التيقاموا بها من أجل التأثير على قرار " المخزن " وارادته ، سواء فيما لهعلاقة برغبتهم بأبعاد قطعان الخنازير البرية عن بلدتهم ، أو من أجل اطلاقسراح " بيهي " الذي سجن بسبب موقفه من قطعان الخنازير البرية ، كرمزللتضحية والبذل من أجل المبادئ الانسانية ، والدعوة الى الصبر ، تحيل علىالذهنية الاتكالية والاستسلامية ، الفاقدة لأفق النضال من أجل انتزاعالمطالب العادلة ، التي يحاول الفقيه ، أن يزرعها في قلوب الناس ، التيقوبلت بالرفض ، والتوق الى اخراج الألم وتحويله الى فعل التعبير عنالمعاناة بالفعل الجاد والمنتج لثماره .
البعد النفسي و العاطفي في الرواية.
يتجلىالجانب النفسي والعاطفي في الرواية في العديد من الأحداث والوقائع ، الخوفوالأرق وكثرة الهواجس ... الذهاب بعيدا في التخمينات حد التفكير أو التنبؤبكون" بيهي " قد يكون حفيدا لأحد الصلحاء ،عملية البوح التي قام بها " امغار " للفقيه ، تشبه الى حدما تلك العملية التي يقوم بها النصارى ، عندمايذهبون للاعتراف لدى الأب أو الكاهن في الكنيسة أو الدير ، ونصح الفقيهنابع من الدين الذي يحث على جعل لمجال المعاملات أفضلية على مجال العبادات،... الجانب الانساني في شخصية أمغار " أوبوهو " استعمل الكاتب تقنيةالمونولوج من أجل أن ينقل الى القارئ ، كافة العواطف الجياشة والأفكاروالأحاسيس المتوارية في نفسية أمغار ، كشخصية ترمز الى العنفوان والقوة لاالى الخضوع والاستسلام ، لكن ههنا ، فان لها آهات وهنات ،" أبوهو " ، لايستطيع أن يبوح ، لغيره بما كان يعتمل في صدره ، والا أصبح شماتة الشامتين ،الجاه والسلطة ، الألم والمعاناة ، رديفان أساسيان ، الاحساس بالذنب ، والشعور بكون معاناته النفسية ما هي الا نتيجة الظلم والعدوان الذي يمارسهعلى الأخرين ، وبالأخص ، على أبناء جلدته ، أبناء دوار " أروكو " ، وكتتويجلذلك كله تأتي مساهمته في حبس " بيهي ن وايشون " في قمة الأفعال التيتستوجب الندم العميق ، حالة نفسية عصيبة شبيهة بحالة الطغاة والجبابرةالذين تقتلهم الهواجس والتخمينات والتهيؤات ، التحليل النفسي لايقف في متنالرواية عند تحليل نفسية أمغار فحسب ، بل ان وصف حالة" بيهي" وهو بداخلالسجن ، وكل الأفكار التي تدور برأسه ، والتساؤلات التي تؤرق باله ، ماهيالا وجه من أوجه التحليل النفسي لشخصية " بيهي " ، فبالنسبة" لبيهي" الذيدخل السجن من أجل قضية عادلة ، هي الدفاع عن حرمة البلدة التي استباحهاالخنزير البري ، ليس هناك سجن شريف وآخر غير شريف ، لأنهم في السجن لايفرقون بين سجين شريف وآخر وضيع ، فالسجناء بالنسبة لهم كلهم مجرمونويستحقون العقاب ، اشارة من الكاتب الى اشكالية سجناء الرأي بالسجونالمغربية ، والذين يزج بهم بين المجرمين المتضلعين في القتل وتهريب الأشخاصوالمخدرات ،وبواسطة تقنية المونولوج يبرز الكاتب الحالة النفسية ل " بيهي " التي هي حالة نفسية مشوبة بالقلق والحزن والألم العميق ،... يتجلى التحليلالنفسي أيضا في متن الرواية ، في وصف حالة " أمغار " أوبوهو" ، خاصة بعدنزع السلطة من يده ، ووضعها في يد غيره ، أي " بيهيش " ، فوشاية" بيهيش" بأهل البلدة، أثناء عزمهم تنظيم مسيرة الى أمام باب المحكمة للتنديد بحكمهاعلى " بيهي " أدى الى تدارك الأمر ، وافشال مخطط أفراد البلدة ، الشئ الذيلم يكن واردا في معطيات " أوبوهو " كان سببا في نزع السلطة من يدهووضعها في يد غيره ، بالرغم من أصوله المتواضعة، احالة الى ارتكاز الولاءالمخزني على الوشاية أكثر منه على الفعالية والاخلاص ، وازاحة " أوبوهو " عن " المشيخة " أو " تموغرا" ، سبب له ألما عميقا ، وحزنا أخرسا قاده الىالجنون ، هذه الفرضية ، تحيل على مسألة اعادة انتاج النخب ، التي اشاراليها الدكتور على حسني ، في كتابه :" تاريخ المؤسسات والوقائع الاجتماعية " ، بحيث يرى أن مؤسسة المخزن في القرن 19 ، ترتكز على مسألة انتاج النخبواعادة انتاج النخب ، وأورد قصة الوزير المنبهي، الذي كان صدرا أعظم في عهدالسلطان الحسن الأول ،كيف انقلب عليه الأمر ، في عهد السلطان عبد العزيز ،بحيث قام " الصدر الأعظم " المسمى " با أحمد " بإزاحته ليحل محله ، ونكلبه وصادر أملاكه ،... حالة أخرى من حالات التحليل النفسي ، تتجلى في عدمقدرة " بيهي " على البكاء ، أثناء جلساته مع أولئك الأشخاص الملتحين ، كمايفعلون هم ذلك بكل بساطة ، بحيث لاحظ أنهم يستطيعون البكاء وقتما شاءوا ،في حين تستعصي على مقلتيه الدموع، لأن الرجل في عرف الثقافة البدوية يجب أنيكون قوي الشكيمة، متواري المشاعر والأحاسيس الرقيقة ، والا أصبح عرضةللسخرية والامتهان ، كما يرى هو ذلك ، نفس الأمر حدث للفنان الأمازيغيالمناضل ، الراحل معتوب لوناس ، أثناء اعتقاله في الجبال بمنطقة القبائل في سنوات العشرية السوداء كما يسميها أشقاؤنا في الجزائر، بحيث ذكر ضمنمذكراته التي نشرها بعنوان :" المتمرد " ، كيف كان أفراد الجماعة المسلحةالذين ألقوا القبض عليه ، يستدرون البكاء بسرعة أثناء وقوفهم في الصلاة ،كونه لم يكن قادرا على مجاراتهم في البكاء ، في حين كان يتساءل ويستغربكثيرا سبب بكائهم ، في الوت الذي يرتكبون فيه فظاعات انسانية ،تندرج فيقائمة جرائم الحرب .
فيالانثروبولوجيا المغاربية لمحمد أركون ثمة احالة الى كون التشاؤم بأصواتالبومة ،عبارة عن اعتقادات وتهيؤات وتمثلات اجتماعية لها أصول في الطقوسالوثنية الضاربة في أعماق الثقافة المغاربية ، والمعتقد الديني والايمانييقف في الوسط بين التمثلات الطقوسية ، والأفكار المستنيرة التي يرفضها هذاالنمط من التفكير كمخلص من تلك المعتقدات الخاطئة ، المرتكز على حشو ذهن " بيهي" بأفكار الجماعات الدينية عن الجهاد والقتال في البلاد البعيدة " تلاجستان " ضد الكفار والأموات الذين نهضوا من مراقدهم ليقاتلوا الى جانبالمجاهدين ، هذه المقولات شحذت ذكاء " بيهي "، الذي لطالما ، حاول التخلصمنها ، بفعل ذهنيته المتمردة ، وذكائه المتقد ، في خضم ذلك تنتاب حيرة عقله المتقد وقلبه المندفع نحو التصديق التلقائي لكل ما يقوله الداعية ،أو مرشد الجماعة " بومسعود " الذي ادعى أن" بيهي" كان يتمنى أن يذهبللقتال في بلاد " تلاجستان " ، هذه الفرضية تحيل على مسألة تجييش الناسوارسالهم الى القتال في بلاد بعيدة ، باسم الجهاد المقدس ضد الكفار ، وهيممارسات وسلوكيات الجماعات الدينية ، غير أن الشك التلقائي وليس المنهجيبتعبير ديكارت ، الذي يتأجج في عقل " بيهي " هو الذي دفع به الى الخلاص منقبضة الدعاة المحترفين أو طيور الظلام " ئكايوار ن تيلاس " ، كما تطلقعليهم زوجته ، " اجة "، التي كانت ترفض وتعارض بشدة ، انتماء زوجها لتلكالجماعة الدينية .
البعد الاجتماعيفي الرواية :
يتجلىالجانب الاجتماعي والتاريخي في متن الرواية ، في قدرة السلطة على تحويلمعاناة سكان " أروكو " ، الى قضية ذات أبعاد كبيرة مثل قضية البيئة ، ولذلكفان النملة التي هي مجرد حشرة صغيرة استطاعت ان تتوارى خلف الفيل ، أوالخنزير البري ، بتعبير الكاتب في الفصل الثاني من الرواية ، بحيث قامتالسلطةبإحضار المنتخبين ومندوب البيئة وقامتبتنظيم لقاء تواصلي مع أهل بلدة " أروكو " من أجل أن تشرح لهم أن ما قامت به من افراغ قطعان الخنازير فيمحيط البلدة ، ما هو الا اجراء يهدف الى الحفاظ على البيئة ، وتم لأجلاقناع الناس بهذا الأمر استعمالها لكل الوسائل المتاحة من أجل " أن تمر هذهالعملية في أحسن الظروف " وكما تريد السلطة ، ومن ضمن هاته الوسائلالمتاحة ، استعمال الدين لنفس الغرض واحضار الفقيه من أجل تلاوة القرآن ،ودعوته الى التركيز على الآيات التي ذكرت فيها الحيوانات ،الا أن عدم فهم الفقيه لمغزى الاجتماع وانجراره وراء القراءة الآلية للقرآن ، جره الى ذكرالآيات التي تشير إلى كون الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوا فيها وجعلوا أعزةأهلها اذلة ...الخ ، الشيء الذي أغضب ممثلي السلطة الذين ،أوصوابإزاحته منامامة المسجد فيما بعد ....، كما تم احضارلافتة كتب عليها ما معناه : " حياتنا ترتكز على بيئتنا ، لنجعليدا في يد من أجل ازدهار بيئتنا والحفاظعليها " ، الحادث له دلالات أراد الكاتب أن يبرز من ورائه رأيه حولعدم قدرةالسلطة على فهم احتياجات الناس الحقيقية أو على الأقل تجاهلها لتلكالاحتياجات وعدم ايلائها الأهمية التي تستحقها ، الشيء الذي يوضح ديماغوجيةالمخزن ، من حيث عدم اتضاح الرؤية فيما يرمي اليه بالنسبة لسكان البلدة ،الذين يرون أن الخنازير البرية تعتدي على أملاكهم ، ويجب أن ينكفئ هذاالاعتداء عنهم ، فقط ، هذا ما يريدونه ، أما مسألة الحفاظ على البيئة ، فهيلا تدخل ضمن الأولويات بالنسبة لهم ، هم الذين لا يفكرون الا في رغيف خبز،لا يستطيعون أن يفهموا كنه هذه الأمور، والحفاظ على البيئة يجب ألا يأتيعلى حسابهم وعلى حساب أرزاقهم التي تأتي من حقولهم الجبلية الضيقة ،الشيءالذي لا يريد " المخزن " أن يستوعبه بدوره ، بحيث كون السكان بالنسبة اليه ،ما هم الا جزئية صغيرة ضمن معادلة كبيرة جدا تسمى :" تدبير المجال " ، ... عدم الاتيان على ذكر الحيوانات من النائب البرلماني ، تحيل على التناقضالصارخ في اطروحات المخزن ،وعدم قدرته على اقناع هؤلاء البسطاء بأطروحتهالتنموية والبيئية ، كما أن عدم ارتكاز المحاور المثارة ضمن الحديث الموجهالى السكان على موضوع الخنازير البرية ، بالرغم من كونه الموضوع الرئيسيلمجيئ تلك البعثة الى الدوار ، يحيل على كل ذلك ، استعمال الأمثال من طرفالكاتب ، لتبيث هذه الفكرة في ذهن القارئ ،مثل قوله على لسان أحد الشخصيات :" ئغ ئرا ئميلو تزارت ئكد تيكيضوت " ،طريقة " أباشوش " في الكلام ،والمداخلة التي قام بها ، وعدم الاعتراض على مداخلات من سبقوه ، بلوالتنويه بها ، جزئية تبين عدم جدوى التمثيلية السياسية للمنتخبين الذين لايمثلون الا انفسهم ولا يدافعون عن قضايا مواطنيهم ،بمعنى كونهم يدورون فيفلك السلطة ، ويتقون غضبها ، ويطمعون في أعطياتها ويجنون المنافع من ورائها، في اشارة واضحة من الكاتب الى أزمة التمثيلية السياسية في مجتمع لميستوعب بعد الدرس الديمقراطي ، بما هو ، حرية رأي وتعبير ، ودفاع عن قضاياالشأن العام ، وليس مجرد التصويت في يوم الانتخاباب ، تأتي في نفس السياقمداخلة أحد الحضور ، الداعية الى الاهتمام بالإنسان الذي هو محور البيئةوالتنمية ، جانب آخر من الجوانب الاجتماعية المتواترة ضمن المتن الروائي ،اذ انبرى شاب وأذهل الحضور بمداخلة قيمة ، " ايوس ن تبركانت " حث المتدخلينعلى ذكر أسماء الأماكن باللغة الرسمية ،أي اللغة الأمازيغية ، هذه نقطةنظام من أجل اعادة الأمور الى نصابها، خاصة في مثل هذه الاجتماعات الرسمية،التي يذكر فيها أسماء الأماكن الجغرافية معربة أو مفرنسة ، وبغير اللغةالتي تحمل دلالات ومغازي تلك الأسماء والأعلام ، بحيث جاء اسم " أروكو " على شكل " أروكاتة " و " توكاومان " على شكل " قلعة الماء " و" ئوزيون " على شكل " أوزيوة " ، علامة دالة على أن الكاتب تؤرقه هذه المسألة كما تؤرقجميع المناضلين الأمازيغيين الذين يقفون في كل يوم أكثر من مرة على مثلهذه الممارسات التي تحط من قدر اللغة والثقافة الأمازيغيتين ، وكذا من قدرالانسان الأمازيغي ، وانتقد سياسة الدولة في تدبير المجال الغابوي ومصادرالمياه في علاقتها بالمحيط السوسيواقتصادي ، وبالإنسان الذي هو القطبالأساسي في المعادلة البيئية والطبيعية ، " ئيويس ن تبركانت " ساقه الكاتب ،كنموذج للشاب المثقف الذي غالبا ما يفاجأ أفراد البعثات التي تزور مثل هذهالدواوير النائية ، بوعيه اليقظ وبديهته الوقادة وذكائه المتقد ، في حينجاءت مداخلة " الدكتور أحيون " ضمن جلسة الأعيان " ضمن الفصل الرابع، الذيعنونه الكاتب :" توكاومان أو قلعة الماء " ، بعد جلسة المسؤولين الكبار " انغلافن " كرد على مداخلة الشاب ، لتبرز على أن الدولة لاتستطيع أن تسيطرعلى الأماكن والمناطق أو المجال بصفة عامة دون أن تحرف أسماء تلك الأعلام ،لأن تسمية الأماكن بأسمائها الحقيقية يعني ارجاع الحقوق لأصحابها ،واعتراف بالحق التاريخي للسكان على أراضيهم ومجالهم الغابوي ، وخلص الىمايلي : اذا أردت أن تحكم الأرض يجب أن تحكم الاسم ، هنا تبرز وبشكل كبير ،تيمة الأرض ، تدور حولها قيمة فلسفية عظيمة تتلخص في التساؤل التالي : لماذا ترغب الدول الغازية في محو آثار الحضارات السابقة لغزوها ؟ اذا لميكن هدفها هو احتلال الأرض و طمس كل الحقائق التاريخية الدالة على تلكالحضارات السابقة، ساقها الكاتب في مداخلة " أحيون " ، هل يجب أن نتذكر أناسم أحيون يحيل على البعد اليهودي في الهوية المغربية ؟ لست أدري تمامالماذا جاء في متن الرواية ذكر هذا الاسم اذا لم يكن من أجل هذه الغاية ،ومداخلة "أحيون " دعوة الى عودة الوعي الى العقلاء من أصحاب الأرضالمتواجدين بالمراكز المرموقة ، قصد اعادة الأمور الى نصابها ، وهذه مسألةأخرى من ضمن المسائل الكثيرة التي تؤرق بال السارد أو الكاتب ،ومصطلح " أيتأودرار " تحيلني على جمعية سكان الجبال العالمية ،التي تدافع عن الوجودالتاريخي للسكان بالجبال ، والدعوة الى استفادتهم من ثمار التنميةالمستدامة ، وعدم اقصائهم اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، أما مداخلة " بوعمران " وهو أحد الوجهاء بالمنطقة ، حول التركيز على ضرورة انخراطالبلاد في ثقافة حقوق الانسان ، فقد ايقظت شكوك " اويس ن تبركانت " حولقدرة" بوعمران "على انجاح مشروعه الذي أوقفه " بايوزيون" ،بمعنى كون" بوعمران" ليس جادا في طرحه الا من خلال رغبته في استمالة السكان من أجلانجاح مشروعه المتمثل في تعبئة المياه المعدنيةالمتواجدة بإحدى مصادرالمياه بالمنطقة ، في قارورات موجهة للتسويق ، أو بتعبير آخر تحالف المنافعالاقتصادية للنخب مع المنافع السياسية ، ضدا على مصالح السكان البسطاء.
الخط الزمني و التنظيم المكاني للرواية.
أروكو يعني في اللغة الأمازيغية ، الاناء ، والاناء له دلالة بالنسبة لأهلتلك البلدة ، من حيث كونه يدل على التئام الأسرة أو العشيرة من أجل تناولالطعام ، انه يرمز الى الدف ء الأسري ، والحميمية العشائرية ،في المجتمعالمغربي التقليدي ،وهو المكان الذي دارت فيه جل أحداث الرواية ، كما أنهيعتبر بؤرة الرواية نفسها ، اذ فيه وبسببه وقعت مجموعة من الأحداث التيشكلت المتن الروائي ، بكل ما يعج به من أسماء الأماكن وأسماء الشخصيات وعلىأساسه استعمل الكاتب مجموعة من التقنيات التواصلية ، والأدبية ، والفنية ،من أجل أن يوصل الى القارئ فكرة ، معينة ، عن مكان ما ، على كوكب الأرض ،يقوم فيه الانسان وتحت يافطة مسميات عدة ، بقهر أخيه الانسان ، ومحاولةمصادرة حقه في الحياة ، " وأروكو " من حيث كونه اسم علم جغرافي ، لبلدةتقع في قلب الجبل ، تمثل مناطق الظل ، أو المغرب العميق ، حيث تعيش ، طبقةاجتماعية ، كل أنواع الاقصاء الاجتماعي والاقتصادي ، وكل صنوف القهروالجبروت التسلطي ، وهي اذ تتعرض لهذه الممارسات المهينة للإنسان ، تصدرأناتها , آهاتها ، لكونها تتألم ، غير أن ألمها لا يشعر به أولئك القائمونعلى الشأن السياسي بالبلاد ،بيد أن هؤلاء لديهم حسابات أخرى تعتبر من ضمنأولوياتهم ، انها منافعهم الاقتصادية ، واستراتيجياتهم السياسية في السيطرةوالتحكم ، فاذا كان المجال الحضري وذلك بالنظر الى تركيبته الاجتماعيةوالديمغرافية يفلت من رقابة السلطة وجبروتها، فان العالم القروي أو المناطقالخلفية ، تعد المرتع الرئيسي لكل الممارسات الهادفة الى اعادة صياغةالمشهد السياسي وفق التوازنات المرغوبة من الخلف ذاته ، وهي لعبة معقدة جدالا يفهمها أولئك البسطاء ، الرابضون في الأعالي ، وبين الأدغال والأحراش ،المجاورون للوحيش والتضاريس الوعرة والمناخ القاسي .
الروايةتقع في 194 صفحة ، تضم 15 فصلا ، بالإضافة الى معجم ،اتبع فيها الكاتبالخط ، التصاعدي المتذبذب بين تقنيات سردية متنوعة ومتناغمة ، تتوزع بينالمونولوج والاسترجاع والوصف والشرح والحوار ، ووظف فيها الأمثال والأشعار، تخترق أزمنة يختلط فيها النهار بالليل ، والشهر بالسنة ، لايكاد عمرها يتجاوز بضع سنوات ، يتجلى ذلك في ذكر ضمن الكاتب للفصل السابع ،كون " بيهي " قضى الى حدود ذلك سنتين في السجن ، لكنه في مكان آخر ، يذكرأن " بيهي " ، قضى تلاث سنوات سجنا ،بما يفيد أن زمن الرواية متقارب جدا ،كون الأحداث التي أثرت المتن الروائي لا تفصل بينها مسافات زمنية بعيدة،كما أن الفترة الزمنية أو التاريخية ، التي تناولتها أحداث الرواية ، هيالفترة المعاصرة ، ومؤشرات عديدة تدل على ذلك ، لهذا فيمكن القول أن بعضالأعلام الجغرافية المذكورة في متن الرواية مثل " ئوزيون " تعد أعلاماجغرافية لمناطق واقعية ومعروفة جدا ضمن خارطة منطقة سوس ، كما أن الصورةالخارجية للرواية ، وهي تظهر مشهدا لإحدى الدواوير المتواجدة في الجبال ،لن يكون ذلك الدوار الا احدى الدواوير المتواجدة بالأطلس الكبير الغربي ،بالنظر ليس فقط الى الطابع العمراني للمنازل البسيط جدا ،من حيث الموادالمستعملة التي لم تتأثر بعد بالمواد الحديثة كالإسمنت والحديد والآجر ،على غرار بعض الدواوير المماثلة ، لكن بالنظر الى مشهد المدرجات الضيقة ، والتي تبدو شديدة الانحدار نحو السفح ، والمستغلة في حالات مماثلة فيزراعات دورية مثل الشعير والذرة وبعض الخضر وات ،تتخللها بعض الأشجارالنفضية ، غير المورقة ، مما يوحي بكون الصورة أخذت شتاء ، والمنظر العامللدوار الظاهر بالصورة على الغلاف الخارجي للرواية ، يعطي الانطباع علىأننا أمام دوار جبلي لم يتأثر كثيرا بالوسائل العصرية المتاحة في غيره منالدواوير المماثلة ، تفسير ذلك أحد أمرين : اما عدم ربطه بالمسلك الطرقيالذي يمكن من نقل تلك الوسائل، وهو افتراض ضعيف بحكم كون مجموعة من اللجانالتي سيرتها السلطة تحضر الى الدوار، مع أنه في بعض دواوير الأطلس الكبيرالتي تفتقد للمسالك الطرقية ، لايزال يتنقل الناس وحتى أعوان السلطة علىظهر الدواب ،وبالتالي نحن أمام مستوى من الدواوير الجبلية المتواجدةبالأطلس الكبير الغربي ،التي تعيش عزلة مطلقة عن العالم الخارجي ، أوللمستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة القريب جدا من الفقر والهشاشةالمطلقة ، علاوة على كون جل ان لم يكن غالب الأحداث المتضمنة في الرواية ،هي من صميم الواقع اليومي المعاش لمجموعة من الدواوير المنتمية الى مايصطلح عليه بالمغرب العميق ، أو المناطق الخلفية ، حيث يعيش الناس في أسفلالسلم الاجتماعي ، مجبرين على التعايش مع الخنزير البري ، معتمدين على بعضالمزروعات المعاشية التي تتلفها في الغالب عربدة جحافل الخنزير البريالتي تطلقها وتحميها السلطة ضدا على ارادة وحقوق السكان ، وعلى بعض قطعانالماشية ، بالإضافة الى الهجرة التي تعتبر في بعض الحالات المورد الرئيسيللعائلات التي يمدها أفرادها من المدن بالمال اللازم من أجل استمرار الحياة، فان الخط الزمني للرواية ، متساوق مع خط الأحداث ، بحيث انصبت معضلةالخنازير البرية التي أفسدت الحياة على سكان هذا الدوار الهش ، لتجعل كلالآفاق مسدودة ، مع انعدام الحلول الجدية ، وانعدام الرغبة الأكيدة من طرفالسلطة قصد ايجاد الحلول الملائمة ،... وأمام معضلة انسداد الأفق لم يتبقىللسكان الا خيارين اثنين اما البقاء ومواجهة قطعان الخنزير البري بمزيدمن الصبر ، مع أنهم لا يستطيعون قنصها ، لكون القانون يمنع بشكل مطلقاصطياد أو قنص الوحيش ، الا بموجب شروط وضعتها الادارة الوصية على الغاباتلهذا الغرض ، بمعنى الاندحار البطيء، أو بيع أملاكهم لشخص ثري آت منالمدينة أي الانسياق وراء الحل الذي أجد أنه – ربما – ليس حلا نابعا منارادة السكان أنفسهم ، الا لكون الكاتب ونظرا لانسداد الأفق السردي أمامهلم يجد أما مه الا هذا الحل ، بحيث أمام رغبته في انهاء الرواية على نحومعين ، وايجاد حل لعقدتها المعقدة بغياب الحل الذي يجب أن يأتي اما منالسكان أو من السلطةنفسها ، قرر أن ينهيها على هذا النحو ،في حين أن الحلالمقبول في مثل هذه الحالات ، لا يجب أن يأتي من الخارج ، أي خارج الدوارأو خارج السلطة ، وبالتالي خارج السياق ، لذلك فاني اعتبره حلا مفتعلا منقبل الكاتب للتخلص من عقدة الرواية ، التي وصلت الى ههنا ، بدون حل ، بحيثلا يعقل - وهذا في عرف الذهنية البدوية لسكان الجبال – أن يأتي أجنبي ويزعم أنه ينوي شراء تلك المدرجات الشحيحة فيجد أمامه الطريق سهلة ومعبدة،فقط من أجل أن يخلص سكان " أروكو " من محنتهم ؟ هذا أمر مستبعد جدا، لهذافاني أعتقد أن الحل الذي أورده الكاتب في نهاية الرواية حل مفتعل ، ومعذلك فان للرواية جمالية تخييلية لا يمكن أن تخطئها العين المتفحصة والعقلالناقد.
الأسلوب، لغة الرواية، و مجالاتها.
يظهر جليا من خلال أسلوب الرواية مقارنة بالروايتين السابقتين لنفس الكاتب، أن هذا الأخير بذل مجهودا جبارا في التعبير بلغة أمازيغية أدبية شفافةورشيقة ، الشيء الذي لم يكن متاحا في الكتابة باللغة الأمازيغية من ذي قبل،ذلك الأسلوب الذي يمتاز بالرشاقة والسلاسة والبلاغة العميقة ،كما تتجلىجمالية النص الروائي المدروس في استعمال التعابير المستحدثة والتعابيرالأصيلة جنبا الى جنب، وكذا المصطلحات الحديثة ، فعملية النبش في المعجمالأمازيغي وعدم الاقتصار على المرادفات الجاهزة ، بمعنى عدم الاكتفاءبالمستوى اللغوي الكامن في التعبيرات الشفوية ، بل و مع ايرادها بكثرة يمكنأن نلاحظ أن أسلوب الرواية تتخلله تعابير ومرادفات مستحدثة أيضا ، مثالللتعبيرات المستعملة في الشق المحكي بالمناطق اللهجية على الأقل بالمغرب ،أذكر " تمسومانت " وهو تعبير متداول بالأطلس المتوسط ، ويعني : بذل الجهد ، " حوما " وهو متداول بمنطقة الريف ، ويعني :لأجل ، " غاس " وهو متداولبالأطلس المتوسط ، ويعني : فقط ، " أمردول " وهو متداول بالأطلس المتوسط ،ويعني : الطبيعة أو البيئة ، " قاع " وهو متداول بمنطقة الريف ، ويعني : الكل ، " جاج " وهو متداول بالأطلس المتوسط ، ويعني : داخل ، " أقبان " ،وهو متداول بالأطلس المتوسط ، ومعناه : الساذج ، " ورئزمر " وهو متداولبمنطقة الريف ، ومعناه : لايقدر أو لا يستطيع ...الخ. في حين استعمل الكاتبمجموعة من التعابير الجاهزة المستعملة بمختلف المناطق الأمازيغية سواءداخل المغرب أو خارجه ، أوردها في الغالب اما على شكل أمثال شعبية أو علىشكل تعابير مجردة ، أو على شكل مختصر لقصص وحكايات متداولة في تلك الجهات ،مثل :" قصة النمس أو بومحند " ....الخ ، واجمالا فان الكاتب استعملأساليب متنوعة وتعابير مختلفة ، منها أسلوب المجاز ، الشعر ، كما استعانبالتحليل النفسي والمونولوج كذلك ، وبذلك فقد طرقت لغة الرواية لمجالاتتعبيرية متعددة المستويات ، رائدة من حيث اكتناف المرامي التعبيرية ،واستكشاف مجاهل وتخوم الأساليب اللغوية الأمازيغية.
من أنا
إجمالي مرات مشاهدة الصفحة
Poll
أرشيف المدونة الإلكترونية
اشترك معنا
المتابعون
أرشيف المدونة
الرئيسية
آخر التعليقات
إعلانات مدفوعة
Blogger news
Pages
اشترك ليصلك جديدنا
تبادل إعلاني
مساحة إعلانية
الارشيف
Pages
يتم التشغيل بواسطة Blogger.
Pages - Menu
ابحث فى الموقع
المشاركات الشائعة
-
tikttay iffgh d tagara ad yan ungal amaynu yura t mass Mohamed Moustaoui, lli ittwayssann s tmdyazt, issufgh d yad mnnawt twckinin...
-
irrut ul n umdyaz ifl d iwrman nns: iwrman n Larbi MOUMOUCH had tazlgha n tirra tDfr sul tizrigin nns s tlalit n twckint t...
-
قراءة في رواية تمورت ن الفاون Tamurt n ilfawn للكاتب محمد أكوناض بقلم محمد أيت بود ت عتبر رواية " تامورت ن ئلفاون" الر...
-
gr igiwal n taba قصص للأطفال لمحمد كارحو محمد أرجدال صدرا مؤخرا للكاتب الامازيغي محمد كرحو مجموعة قصصية خاصة بالأطفال تحت ع...
-
ixfawn d isasan ngh iswingimen ikkerfn ixf ; arra amzwaru n tflsaft tamazight s tmazight =...
-
Tamdyazt tatrart s ughanib n mass Abdellah Elmnnani "Sawl s ighd" Mass Abdllah lmnnani iga yan gh i3rrimn n ugadir ittw...
-
تايدرت ن ؤكماي: مجموعة أناشيد امازيغية للشاعر محمد ادمين صدر مؤخرا مجموعة أناشيد للأطفال تحت عنوان “تايدرت ن وكَماي ” للشاعر محمد ادم...
-
تيمة الهجرة في الرواية الأمازيغية: ئكضاض ن وهران رشيد نجيب تعززت الساحة الأدبية الأمازيغية بصدور عمل روائي بعنوان:”ئكضاض ن وهران” ل...
-
Ismdal n tmagit : au carrefour des identités perdues Après son premier roman Ijawwan n tayri 1 (Les siroccos de l’amour) qui a fait ...
-
azul flawn aitma distma imazighen .n masri ( asdrfn uswingm d unili ) ad right ad ig asays n tirra s tmazight, negh tirra f warra...
المشاركات الشائعة لهذا الشهر
-
tikttay iffgh d tagara ad yan ungal amaynu yura t mass Mohamed Moustaoui, lli ittwayssann s tmdyazt, issufgh d yad mnnawt twckinin...
-
irrut ul n umdyaz ifl d iwrman nns: iwrman n Larbi MOUMOUCH had tazlgha n tirra tDfr sul tizrigin nns s tlalit n twckint t...
-
قراءة في رواية تمورت ن الفاون Tamurt n ilfawn للكاتب محمد أكوناض بقلم محمد أيت بود ت عتبر رواية " تامورت ن ئلفاون" الر...
-
gr igiwal n taba قصص للأطفال لمحمد كارحو محمد أرجدال صدرا مؤخرا للكاتب الامازيغي محمد كرحو مجموعة قصصية خاصة بالأطفال تحت ع...
-
ixfawn d isasan ngh iswingimen ikkerfn ixf ; arra amzwaru n tflsaft tamazight s tmazight =...
-
Tamdyazt tatrart s ughanib n mass Abdellah Elmnnani "Sawl s ighd" Mass Abdllah lmnnani iga yan gh i3rrimn n ugadir ittw...
-
تايدرت ن ؤكماي: مجموعة أناشيد امازيغية للشاعر محمد ادمين صدر مؤخرا مجموعة أناشيد للأطفال تحت عنوان “تايدرت ن وكَماي ” للشاعر محمد ادم...
-
تيمة الهجرة في الرواية الأمازيغية: ئكضاض ن وهران رشيد نجيب تعززت الساحة الأدبية الأمازيغية بصدور عمل روائي بعنوان:”ئكضاض ن وهران” ل...
-
Ismdal n tmagit : au carrefour des identités perdues Après son premier roman Ijawwan n tayri 1 (Les siroccos de l’amour) qui a fait ...
-
azul flawn aitma distma imazighen .n masri ( asdrfn uswingm d unili ) ad right ad ig asays n tirra s tmazight, negh tirra f warra...
المشاركات الشائعة لهذا الأسبوع
-
tikttay iffgh d tagara ad yan ungal amaynu yura t mass Mohamed Moustaoui, lli ittwayssann s tmdyazt, issufgh d yad mnnawt twckinin...
-
irrut ul n umdyaz ifl d iwrman nns: iwrman n Larbi MOUMOUCH had tazlgha n tirra tDfr sul tizrigin nns s tlalit n twckint t...
-
قراءة في رواية تمورت ن الفاون Tamurt n ilfawn للكاتب محمد أكوناض بقلم محمد أيت بود ت عتبر رواية " تامورت ن ئلفاون" الر...
-
gr igiwal n taba قصص للأطفال لمحمد كارحو محمد أرجدال صدرا مؤخرا للكاتب الامازيغي محمد كرحو مجموعة قصصية خاصة بالأطفال تحت ع...
-
ixfawn d isasan ngh iswingimen ikkerfn ixf ; arra amzwaru n tflsaft tamazight s tmazight =...
-
Tamdyazt tatrart s ughanib n mass Abdellah Elmnnani "Sawl s ighd" Mass Abdllah lmnnani iga yan gh i3rrimn n ugadir ittw...
-
تايدرت ن ؤكماي: مجموعة أناشيد امازيغية للشاعر محمد ادمين صدر مؤخرا مجموعة أناشيد للأطفال تحت عنوان “تايدرت ن وكَماي ” للشاعر محمد ادم...
-
تيمة الهجرة في الرواية الأمازيغية: ئكضاض ن وهران رشيد نجيب تعززت الساحة الأدبية الأمازيغية بصدور عمل روائي بعنوان:”ئكضاض ن وهران” ل...
-
Ismdal n tmagit : au carrefour des identités perdues Après son premier roman Ijawwan n tayri 1 (Les siroccos de l’amour) qui a fait ...
-
azul flawn aitma distma imazighen .n masri ( asdrfn uswingm d unili ) ad right ad ig asays n tirra s tmazight, negh tirra f warra...